Résultats de la recherche: 8

الأسواق ومحترفوها في تاريخ الإسلام
الأسواق ومحترفوها في تاريخ الإسلام
(المراجع محاضرات و دراسات مختلفة)
الحسبة: وكانت تعرف في الغرب الإسلامي بولاية السوق، وممن اشتهر في هذه الوظيفة موسى بن سالم الخولاني وحسين بن عاصم الثقفي الفقيه ولي الحسبة - أو ولاية السوق- وقد وتوفي سنة 263 هـ (876 م) ، وقد تولي نفس المهمة ابنه عبد الله بن حسين وممن تولى الحسبة سليمان بن وانسون ولكن الأمير سرعان ما عزله لأنه رأى أنه أساء الأدب معه،ولم تكن الحسبة منفردة بل كانت تتوازى مع وظيفة أخرى لصيقة بها وهي الشرطة، وقد يتولى المحتسب هده الوظيفة إضافة إلى كونه والي على السوق.
ه- الشرطة: عرفت ثلاثة أنواع ض الشرطة، وهي الكبرى والوسطى والصغرى، ولصاحب الشرطة بعض سلطات القاضي كما يقوم أحيانا بتنفيذ بعض الحدود بعد أن يصدر القاضي الحكم، وربما نظر في الحدود فكان صاحب الشرطة مسؤولا عن الأمن والضرب على أيدي المجرمين، فصاحب الشرطة الصغرى كان مختصا فيما يتصل بعامة الناس أما صاحب الشرطة العليا فيضاف إليه زيادة على ذلك النظر في قضايا الخاصة للناس وكبار رجال الدولة والضرب على أيدي العابثين منهم أو من أقاربهم وحاشيتهم، أما الوسطى فمهمة صاحبها إنجاز بعض الأعمال الخاصة التي يكلفه بها الخليفة لحفظ الأمن، وأغلب الفقهاء والعلماء تولوا الشرطة الصغرى ،ومن هؤلاء حارث بن أبي سعد وكان فقيها ولي الشرطة الصغرى إلى أن توفي سنة 221 هـ(835 م) ، ومحمد بن خالد بن مرتنيل المعروف بالأشج وكان صاحب الصلاة والشرطة معا وكانت وفاته سنة 224 هـ (838 م) ومنهم كذلك ابن عاصم عبد الله بن حسين وكان واليا على الشرطة بقرطبة أيام الأمير محمد ونجد ممن ولي هذه الوظيفة يحي بن ابن إسحاق الطبيب وذلك سنة 302 هـ(914 م) وقد تعد هده الوظيفة في مكانة الوزارة .
الحرف والمهن في أسواق أرض الإسلام :
عند محاولة الحديث عن موضوع الحرف في تاريخ المغرب الوسيط يصدم الباحث بإشكالية ندرة المادة الخبرية، خاصة في الحوليات التاريخية التي أحجمت عن الحديث عن مثل هذه المواضيع، رغم أنه يعتبر حجر الزاوية في الخارطة الاقتصادية والتنموية لبلاد المغرب في العصر الوسيط، فالمؤرخون صاموا عن الحديث الحرفين باعتبارهم من الغوغاء والدهماء وحثالة المجتمع، الذين يصنفون في خانة الجهلة وذوي تفكير ساذج وقدرات عقلية محدودة، وكما هو معروف فجل الكتابات التاريخية كان محورها تأليفها الدول والملوك، ويزاد الشكل تجاه التجاهل إذا أدركنا كره هذه الفئة للسلطة وعلاقتها المتشنجة معها بسبب ما تفرضه من جباية .
وأمام هذه العتمة من قبل المصادر التاريخية وجب البحث عن البديل لسد ثغرات هذا النقص، فكان لزاما طرق أبواب أنواع أخرى من المصادر ونخص هنا كتب الجغرافيا وكتب المناقب والتراجم والأدب والفقه والنوازل وكتب الحسبة، والتي زخرت بمعلومات هامة عن الحرف والحرفين ومجالات شغلهم وتنظيماتهم وأوضاعهم العامة.
وقبل الحديث عن الحرف وجب منهجيا إعطاء تعريف للحرفة و المهنة والفرق بينهما، وإن كان ذلك يعتبر من الأمور الملغزة التي يمكن أن تدفع بالباحث إلى الوقوع في الزلل و المحظور إذا لم يضعها في نطاقها الزماني والمكاني، فلا يمكن الاعتماد على تعريف يرجع إلى عصر بعيد عن الزمن الدراسة ولا إلا مكان غير المغرب الإسلامي .
المفاهيم:
أولا : الحرفة :الحرف كل شيء طرفة وشفيرة وحده وحروف الهجاء ، الصنعة لغة : واصْطَنَعْتُ عند فلان صَنِيعةً، وفلان صَنيعةُ فلان وصَنِيعُ فلات إذا اصْطَنَعَه وأَدَّبَه وخَرَّجَه ورَبَّاه. وصانَعَه: داراه ولَيَّنَه وداهَنَه والمُصانَعةُ: أَن تَصْنَعَ له شيئاً ليَصْنَعَ لك شيئاً آخر، وهي مُفاعَلةٌ من الصُّنْعِ. وصانِعَ الوالي: رَشاه. والمُصانَعةُ: الرَّشْوةُ. وفي لمثل: من صانَعَ بالمال لم يَحْتَشِمْ مِنْ طَلَب الحاجةِ .
ثانيا : اصطلاحا : الحرفة معناها الصناعة فقد قيل فلان محترف صانع وفلان حريفي أي معاملي ، والحرفة من الاحتراف وهو الاكتساب وكل ما اشتغل فيه الانسان .
إن الصنعة العملية هي إخراج الصانع العالم الصورة التي في فكره، والمصنوعات أربعة أجناس: بشرية وطبيعية ونفسانية وإلهية. فالبشرية مثل ما يعمل الصناع من الأشكال والنقوش والأصباغ في الأجسام الطبيعية، في أسواق المدن وغيرها من المواضع. والمصنوعات الطبيعية هي صور هياكل الحيوانات، وفنون أشكال النبات، وألوان جواهر المعادن.
ويعرفها ابن خلدون فقال:« اعلم أن الصنائع في النوع اإلنساني كثيرة لكثرة االعمال المتداولة في العمران بحيث تشد عن الحصر وال يأخذها العد، منها ما هو ضروري كالفَلحة والبناء والخياطة والتجارة والحياكة وأما الشريفة بالموضوع فكالتوليد والكتابة والوراقة والغناء والطب »
الحرفة أو الصنعة في ذهنية ساكنة بلاد المغرب:
اختلفت النظرة إلى أهل الصنعة والحرفة على حسب فئات المجتمع المختلفة فإذا كانت هناك نظرة ازدراء واحتقار من قبل هرم السلطة، ويمكن هنا نستدل بنظرة المحتسب الذي يمثل السلطة والناطق الرسمي بها.
فالمتتبع لكتب الحسبة يرى أنها حملت على نفسها توصيف كل أصحاب الحرف بصفات قد تكون في بعضهم، وقد لا تكون وإنما تكلمت عنها من باب أن الحرفيين كما سبق اعتبروا معارضين للسلطة الحاكمة وبذلك مثلت كتب الحسبة النظرة الرسمية لهؤلاء ، فهم يخلطون العقار الطيب بالعقار الذي دونه، والأشياء الهندية بالبلدية، والحناء المغربلة بغير المغربلة، والقديمة بالحديثة ، أما ابن عبدون فعند وصفه للخبازين يقول"لا يباع الخبز إلا بميزان، ويتفقد طبخه ويتفقد فتاته، فربما كان ملبسا أعني أنهم يأخذون من عجين طيب قليلا ثم يلبسون وجه الخبز، وهو من دقيق غير طيب" ، وقد أيد هذه النظرة المؤرخ المقري حين يقول :" الجاهل الذي لم يوفقه الله للعلم يجهد أن يتميز بصنعة " وإن كان هذا الحكم يحمل في طياته تناقض والذي سيأتي بيانه إلا أنه يبن نظرة فئة من الطبقة المثقفة للصنعة. وفي المغرب تزخر كتب التراجم والمناقب بالأمثلة الدالة على ذلك فالفقيه أحمد بن محمد بن زكري المانوي التلمساني اشتغل حائكا في بداية حاله ، وكان الفقيه سعد بن أحمد بن إبراهيم بن ليون التجيبي من أهل ألمرية طبيبا عارفا ماهرا ، وكان الفقيه أبو الحسن علي الزيات يأكل من كد يمينه معرضا عن خطط الفقهاء ، ولم يختلف حال المتصوفة عن حال الفقهاء فالزاهد أبو محمد عبد السلام التونسي كان يأكل من الشعير الذي يحرثه بيده ، ولم يختلف حال أبو محمد خميس بن أبي زرج الرجراجي الأسود والذي كان " لا يأكل إلا الزرع الذي تناول حرثه بيده وحصاده ودرسه" واشتغل العابد ابو يعقوب يوسف بن علي المؤذن عطارا .
وإذا كان الفقيه و المتصوف له هذه النظرة للحرفة بل وحتى ممارستها، و انطلاقا من أن الفقهاء والصلحاء يعتبران جزء لا يتجزأ من المجتمع يعيش فيه ويشارك ساكنته أقراحه و أفراحه هذا من جهة، ومن جهة أخرى كان المجتمع ينظر إلى هؤلاء نظرة هالة و تقديس و اعتبروا قدوة لغيرهم من فئات المجتمع فنظرة العامة للحرفة اصطبغت بنظرتهم لمن مارسها فزادت مكانتها في النفوس، فقد تواصى فتيان قرية رجراجة على حصاد فدان الزاهد أبو محمد خميس بن أبي زرج دون إعلامه بذلك، فلما علم بذلك أمرهم أن يكفوا، فقالوا ما حصدنا إلا طائعين متبرعين، فقال يكفيكم ما حصدتم .
-الطباخون:
درست كتب الأغذية كانت بالمغرب والأندلس ومن ذلك ما ذكره ابن خير الاشبيلي فيما رواه عن شيوخه من مصنفات أهمها "كتب الأشربة" و"كتاب الشجر والنبات" و"كتاب التمر" و"كتاب المعزى والابل والشاء " .ومن التأليف فيه ومن ذلك كتاب ابن عبد ربه الفريدة الثانية في الطعام والشراب، وكتاب الطعام من المخصص لابن سيده، وأرجوزة في الأغذية للسان الدين بن الخطيب وأرجوزة في الأغذية والأشربة لابن قنفد وكتاب ابن رزين التجيني فضالة الخوان في طيبات الألوان والطعام وغيرها.
والمتصفح لكتب الطبخ يجد أن جل الأطباق كان الدقيق مكون أساسي فيها وهو ما أدى إلى التدليس والغش فيه، ومن خدع بائعي الدقيق خلط الطيب مع اللطيف ويبيعون الجميع بسعر الجيد الذي وضعه المحتسب، أو الطيب على اللطيف ليراه المشتري ثم يغرفون له من الوسط ويعطوه له وهو في غفلة عما في داخل الظاهر، ويسمون ذلك المغفر، ومنهم من يخلطه بالنخال الشبيه بالسميد، أما الغربالون فيغشون بعدم تنقية الدقيق من نخالته، والطحانون يغشون بخلط الدقيق الجيد بالرديء أو يخلط بالتراب الأبيض كما يفعل في أرحاء مالقة .
أما الخبازون ففي الغالب كانوا يغشون في خلط الخبز الطيب بالرديء، كما يقومون برش الخبز بالماء والعسل قبل الطبخ وبالزيت بعد طبخه، ويقومون بتقريص الخبز الرديء بالدقيق الطيب فيرى أنه جيد أما في وزن الخبز فكانوا يعملون الخبزة من خبزتين وينقصون في وزن الخبز فمن فعل ذلك كسر وباعه وزنا، وهناك من قال يتصدق به تأديبا لصاحبه .
مما يدخل تحت الطبخ الجزارة وتركزت حوانيت أصحاب هذه الحرفة في بلاد المغرب في وسط المدن، وفي الأحياء وكان عدد حوانيت الجزارين في مدينة فاس نحو الأربعين، أما المسالخ التي كانت تقام فيها عملية الذبح، فتكون على مقربة من الأنهار القريبة من المدن، والهدف من ذلك هو حاجتهم المستمرة للمياه، حيث يحتاجونها في غسل اللحوم وتنظيف الذبائح وكان يمنع الذبح في الأسواق إلا في (القصاري )المـسلخ .
ويجب أن يكون الجزار من أهل الدين والفضل، وأن يستعمل سكينة كبيرة وحادة، ويتوارى عنها إذا قدمها إلى الذبح .
ومن حيل الجزارين والتي بينها المحتسب خلط اللحم البائت باللحم الطري والهزيل بالسمين، وخلط لحم الضأن بالماعز .
3- العطارون:
وهم الذين يعملون في إنتاج المواد العطرية والاتجار بها كالمسك والزعفران ونحوهما وقد عرفت بلاد المغرب صناعة العطور، والتخصص بها، وكان لهم سوق خاص بهم يسمى العطارين . وقد أورد الونشريسي في إحدى نوازله بخصوص هذه المهنة ما سئل الفقيه ابن زرب عن دابة كانت ماشية في سوق العطارين تحت فارس فطارت صخرة من تحت حافرها فكسرت أنية عطر لها قيمة، فأجاب لا ضمان على الراكب وتدل هذه النازلة على انتشار هذه المهنة في المغرب، وكانت العطور لهل قيمة وغالية الثمن. وكان العنبر يستخدم كمادة أساسية في صناعة بعض العطور، وذلك لطيب رائحته، وكذلك خلطه بمواد أخرى .
4-البزازون: هو تاجر الثياب وعموم المنسوجات، وبائع البز يسمى البزاز وحرفته تسمى البزازة وقد اشتهرت أسواق بلاد المغرب بالتخصص بهذه المهنة، ومما يدل على ذلك، ما أشاره إليه الونشريسي في إحدى نوازله بوجود سوق خاص بهم، حيث سئل أبو العباس الغبريني عمن له حانوت بمدينة يكريه منذ واحد وعشرين عاماً لشخص يبيع البز، وهذا الحانوت المذكور يقع مقابل سوق البزازين بمسافة أربعة أذرع، ولم يغير عليه في المدة حال المذكورة مغير، ثم قام عليه أحد البزازين من أهل السوق ومنع صاحب الحانوت من كرائه، حيث زعم إن شاغل الحانوت يلتقي بالذين يجلبون البضائع إلى للسوق البز قبل وصولهم إليه ويمنع من يأتي للشراء من هؤلاء الجالبين من أهل السوق، وهذا ما يسبب لأهل السوق الضرر، فهل يمنع من بيع البز في هذا الحانوت أو لا يمنع لقربه من السوق المذكور وجرى عادته في هذه المدة. فأجاب الغبريني: له أن يعمر الحانوت المذكور ولا يحل له أن يلتقي الجالبين للسوق المذكور حتى يصلوا إلى السوق يبيعونه، يمنع من ذلك أشد المنع، وأما كونه يبيع ممن يأتي للشراء من أهل السوق المذكور قبلهم فلا حجة في ذلك .
-5-الدباغين:
هو المحترف لحرفة دباغة الجلود وقد كانت مهنة الدباغة من المهن المستهجنة بنظر الناس ، وذلك نتيجة للرائحة الكريهة المتصلة بهذه الصنعة وقد اشاره الونشريسي إلى وجود هذه المهنة في بلاد المغرب وكان لديهم صبيان يساعدوهم في مهنتهم ويشرفون عليهم وكان أصحاب هذه المهنة يعدون الجلود للصنع، وكانت هذه من جلود الخراف والماعز والأبقار بالإضافة إلى جلود الغزلان والجمال وينقسم الدباغين في بالد المغرب إلى أربع فئات اختصت كل منها بنوع معين من هذه الجلود . وقد أورده الونشريسي في إحدى نوازله التي تخص أصحاب هذه الحرفة، بقيام رجل في شراء من دباغ ثالثين زوجاً مفصلة بثالثين دينا ارً على أن يتم عملها .
أما المدابغ فكانت تقام على ضفاف الأنهار، وذلك لحاجتهم المستمرة للمياه لغسل الجلود وتنظيفها وكان لهؤلاء الدباغين أسواق خاصة بهم، وكان ال يسمح لهم بإقامة هذه الأسواق في داخل المدن، بل كانت تقام في خارج أسوارها، لأنها كانت تنبعث منها روائح كريهة . كانت هذه المهنة تحتاج إلى أعداد كبيرة من العمال فمنهم من يعمل على إزالة الشعر عن الجلد، وقسم يعدون ذا اكتملت دباغة الجلود انتقلت إلى أصحاب الحرف المسحوق اللازم للدباغة، والقسم الآخر يعمل في صبغ الجلد، المختلفة ليصنعوا منها أشياء متنوعة ، وشاع انتساب المهن الأسماء الأشخاص الذين يعملون في هذه الحرفة مثل قولهم على أبو مطرف عبد الرحمن بن فاخر المعروف بابن الدباغ وكانت دباغة الجلود من أهم الحرف التقليدية في مدينة فاس حيث كانت تشتهر بجلودها الممتازة
6-الخرازون:
هو محترف حرفة خزر الجلود بالمخرز وخياطتها الأغراض مختلفة بخيوط من الجلد أو الكتان، واشتغل هؤلاء في صناعة الأحذية وخرزها، ومن ذلك استمدوا تسميتهم بهذا الاسم وقد اشاره الونشريسي في إحدى نوازله إلى حرفة الخرازين عندما سئل أحد الفقهاء عن الخف الذي يعمله الخراز من مثل هذا النعال الصرارة، هل ينهى الخرازون عن عملها؟ فإن النساء يستعملنها عامدات لذلك، فيلبسنها ويمشين بها في الأسواق ومجامع الناس وربما كان الرجل غافل فيسمع صرير ذلك الخف فيرفع رأسه، فقال أرى أن ينهى الخرازون عن عمل الخفاف الصرارة، فإن عملوها بعد النهي عليهم العقوبة، وأرى أن يمنع النساء من لبسها، فإن لبسنها بعد النهي رأيت أن تشق خرازة الخف ويدفع إليه، وأرى عليها الأدب بعد النهي ، وتدل هذه النازلة على انتشار هذه المهنة في أسواق بالد المغرب، وأشهر صناعتهم هي الخفاف ، وكان بعض الخرازين يلجأ إلى الغش في ترويج بضاعته، فمنهم من يعمد إلى تغليظ حواشي النعل قبل خرزه، وقد نهاهم الفقيه ابن حبيب عن ذلك وأوصى بمنعهم عن هذا العمل .
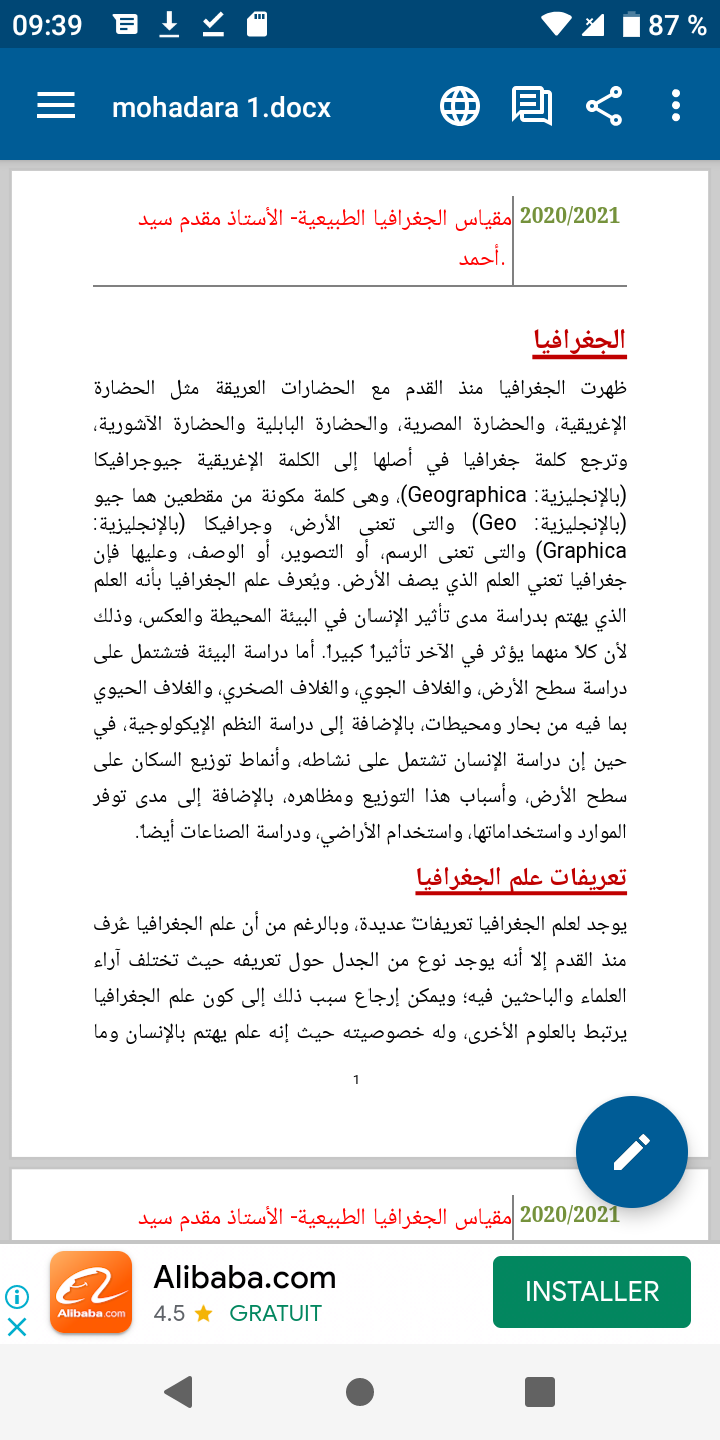
الجغرافيا الطبيعية
حوله، بالإضافة إلى أن لعلم الجغرافيا اهتماماته الظرفية والمستقبلية.[١] وفيما يأتي عدة تعريفات لعلم الجغرافيا:
• الجغرافيا عند الإغريق: هي العلم الذي يصف الأرض.
• الجغرافيا في معاجم اللغة العربية: ورد علم الجغرافيا في معاجم اللغة العربية على أنه العلم الذي يهتم بدراسة مظاهر سطح الأرض الطبيعية، وهو العلم الذي يهتم بتوزيع الحياة النباتية، والحيوانية، والبشرية، كما أنه العلم الذي يدرس النشاط الإنساني وأثره على الأرض، ويكون ميدان الدراسة في علم الجغرافيا الطبقة العليا من القشرة الأرضية، والطبقة السفلية من الجو.
• الجغرافيا في معجم lande Andrela: هي عبارة عن علم يصف سطح الأرض ويفسّر الظواهر الطبيعية، والاقتصادية، والسياسية التي تحدث على سطح الأرض، كما يحلل علاقة هذه الظواهر مع بعضها البعض وعلاقتها بالمكان الذي تحدث فيه.
• الجغرافيا في الموسوعة البريطانية: هي العلم الذي يربط بين علوم الأرض المختلفة والعلوم الإنسانية، كما أنها العلم الذي يحلل الظواهر الطبيعية والبشرية، وأي تغيراتٍ تحدث على سطح الأرض، ويمكن القول إن علم الجغرافيا كما ورد في الموسوعة البريطانية هو العلم الذي يدرس التفاعل بين الإنسان والبيئة في موقعٍ جغرافي معين.
• الجغرافيا عند هارتشون: عرّف هارتشون الجغرافيا بأنها علم التباين الأرضي الذي يتعلق بتوزيع الظواهر الطبيعية والبشرية على سطح الأرض وتحليلها.
• الجغرافيا في معجم لاروس: وردت الجغرافيا في معجم لاروس (بالإنجليزية: Larousse) بأنها كلمة يونانية الأصل مكونة من كلمتين هما جيو (باليونانية: géo) والتي تعني الأرض، وجرافي (باليونانية: graphie) وتعني وصف، وبالتالي فإن كلمة جغرافيا تعبر عن العلم الذي يصف الظواهر الطبيعية الحاصلة على سطح الأرض ويفسرها.
• الجغرافيا عند الجغرافي Pierre George: هي عبارة عن علم يدرس العلاقات باتباع منهج فكري يبدأ من الوصف ليصل منه إلى التفسير مروراً بثلاث محطات أساسية وهي الملاحظة التحليلية، واستكشاف الارتباطات، والبحث عن الأسباب والمسببات.
• الجغرافيا عند Paul Claval: حيث يقول في الجغرافيا إنها العلم الذي لا يهتم فقط بأن يصف الكون أو يفسر كيفية توزيع السكان على سطح الأرض، وإنما هي العلم الذي يبحث في كيفية إدراك البشرية لوجودهم على الأرض، وكيفية تأثرهم وتأثيرهم في المحيط الذي يعيشون فيه.
• الجغرافيا في تعريف اليونسكو: عرّفت اليونسكو الجغرافيا بأنها العلم الذي لا يقتصر فقط على معرفة العلاقة بين الإنسان وبيئته، وإنما تتعدّاه إلى التّفسير والتّحليل لمختلف الأنماط التفاعلية بين الإنسان والبيئة المحيطة.
أقسام الجغرافيا
تُقسم الجغرافيا إلى قسمين رئيسين هما الجغرافيا الطبيعية والجغرافيا البشرية، وفيما يلي نبذة عن كل منهما:
الجغرافيا الطبيعية
وهي الجغرافيا التي تدرس الظواهر الطبيعية التي تحدث على سطح الأرض، وتُقسم إلى عدة فروع وهي:
• علم الجليد: وهو العلم الذي يدرس خصائص الغلاف الجليدي بما يشتمل عليه من الأنهار الجليدية في مختلف بقاع الأرض، كما يهتم بدراسة ديناميكية الأنهار الجليدية ومدى تأثيرها في الأرض.
• علم المياه: ويقوم هذا العلم على دراسة خصائص موارد المياه وديناميكيتها، فيدرس حركة المياه من مصدر إلى آخر سواء كان فوق سطح الأرض أو في جوفها، ويشتمل هذا العلم على مختلف مصادر المياه كالأنهار، والبحيرات، والأنهار الجليدية، وخزانات المياه الجوفية.
• مورفولوجيا الأرض: الجيومورفولوجيا أو مورفولوجيا الأرض هو العلم الذي يقوم على دراسة خصائص وسمات الأرض الطبوغرافية، حيث يدرس الجوانب التي تتعلق بالتشكيلات الأرضية كتاريخها وديناميكيّتها، كما تحاول معرفة التغيّرات المستقبلية التي ستحصل لسمات الأرض وتشكيلها.
• الجغرافيا الحيوية: وتُعرف أيضا بالجغرافيا البيولوجية، وهي عبارة عن علم يهتم بدراسة كيفية التفريق بين الأجناس أو الأصناف البشرية وكيفية توزيعها على سطح الأرض خلال الفترات الزمنية الجيولوجية المتعاقبة، حيث إن لكل منطقة جغرافيا نظامها الخاص بها، ويشتمل علم الجغرافيا الحيوية على عدة فروع تدرس البيئات المختلفة، كدراسة التوزيع الجغرافي للنباتات والذي يعرف باسم الجغرافيا النباتية (بالإنجليزية: Phytogeography)، ودراسة التوزيع الجغرافي للحيوانات ويعرف هذا الفرع باسم الجغرافيا الحيوانية (بالإنجليزية: Zoogeography)، كما يدرس العوامل التي تؤثر على النظم البيئية المعزولة.
• علم المناخ: ويهتم بدراسة كل ما يتعلق بالمناخ المحلي، والعالمي، كما يدرس تأثير النشاط البشري في المناخ والعكس كذلك.
• علم المحيطات: وهو العلم الذي يهتم بدراسة المحيطات لما لها من أهمية بالغة، حيث تحتل ما يقارب 96.5% من المسطحات المائية الموجودة على سطح الأرض، ويشتمل هذا العلم على عدة فروع وهي علم المحيطات الجيولوجي (بالإنجليزية: Geological Oceanography) والذي يدرس النواحي الجيولوجية لقيعان المحيطات، والجبال، والبراكين، وعلم المحيطات الكيميائي (بالإنجليزية: Chemical Oceanography) والذي يدرس التركيب الكيميائي للمياه في المحيطات ومدى تأثير هذا التركيب في الأحياء المائية، وعلم المحيطات البيولوجي (بالإنجليزية: Biological Oceanography) والذي يهتم بدراسة الحياة المائية ونظمها، وأخيراً علم المحيطات الفيزيائي (بالإنجليزية: physical Oceanography) والذي يدرس حركات الأمواج والتيارات المائية وما إلى ذلك.
• علم دراسة التربة: ويهتم علم دراسة التربة (بالإنجليزية: Pedology) بدراسة أنواع التربة المختلفة في مختلف البيئات على سطح الأرض، كما يدرس تركيبها، وتصنيفها، وكل ما يتعلق بها.
• الجغرافيا الفيزيائية: ويُعرف بالإنجليزية باسم Paleogeography، وهو العلم الذي يساعد الجغرافيين على الحصول على المعرفة اللازمة الخاصة بأحوال القارات، والصفائح الأرضية، والسجلات الأحفورية، ويمكن القول إن هذا العلم هو ما يساعد على الحصول على معلومات حول الخصائص الجغرافية المرتبطة بالتاريخ الجيولوجي للأرض.
• الجغرافيا البيئية: وتُعرف أيضاً باسم الجغرافيا المتكاملة أو التكاملية، وتدرس العلاقات بين الأفراد والبيئة المحيطة من الناحية المكانية، ويمكن القول إن هذا الفرع هو عبارةٌ عن مزيج من الجغرافيا الطبيعية والجغرافيا البشرية.
• الجغرافيا الساحلية: وتهتم بدراسة العلاقة الديناميكية بين الساحل والبحر، ودراسة تأثير البحر في حدوث التغييرات على الأراضي الساحلية، بالإضافة إلى دراسة علاقة سكّان الساحل على التضاريس في تلك المنطقة.
• علم الأرصاد الجوية: ويدرس هذا الفرع أحوال الطقس مع تغيّر المكان والزمان، بالإضافة إلى دراسة الظواهر التي تؤثر في الطقس.
• علم البيئة الطبيعية: وهو ما يدرس كيفية تأثير الطبيعة وتغيرها في الأرض والنظم البيئية الأخرى، وقد كان الجغرافي الألماني كارل ترول هو المؤسس لهذا العلم.
• العلم الرباعي: هو عبارة عن فرع خاص بدراسة الفترة الرباعية للأرض، وهي الفترة التي تشتمل على آخر 2.6 مليوني سنة، ويمكّن هذا العلم الجغرافيين من تحصيل المعرفة اللازمة عن التغييرات البيئية التي حدثت في هذه الفترة لاستخدامها في التبنؤ لما سيحدث من تغييرات بيئية في المستقبل.
• علم الجيوماتيكس: وهو عبارة عن فرع من العلوم التقنية التي تهتم بجمع البيانات المتعلقة بسطح الأرض والعمران، ومن ثم تفسيرها وتحليلها.

العمارة الاسلامية من المعرفة إلى الهندسة
العمارة الاسلامية من المعرفة إلى الهندسة
تتميز الحضارة الإسلامية بعمارة غنية ومتنوعة للغاية، فمن المغرب إلى آسيا، ومن إسبانيا إلى أعماق أفريقيا، تتميز هذه العمارة المتعددة برصانة كبيرة في الخطوط ووفرة هائلة في التفاصيل المعمارية.
خصوصيات الفن المعماري الإسلامي
أ- مظهر الفن المعماري
أ/1- إن ممارسة الفن نشأت مع ظهور الإنسان على الأرض. يتضح ذلك من خلال روائع الفن الصخري التي تزين، منذ آلاف السنين، الكهوف التي سكنها الإنسان ما قبل التاريخ، مثل كهوف لاسكو وألتاميرا. تُظهر هذه اللوحات الزخرفية، التي تمثل ألوانًا من أنواع الحيوانات المنقرضة، مهارة وواقعية الإنسان القديم وتشهد على أولوية هذا الناقل للتواصل الذي يمثله الفن فيما يتعلق باللغة والأدب.
أ/2- مع تطور الحضارة الإنسانية أصبح السكن هو المكان الأمثل لإثبات عبقرية الفنانين ومواهبهم. ومن الأدلة على ذلك الزخارف التي تزين المنازل المكتشفة في وادي النطوف (فلسطين) ومريبط (سوريا) والتي يعود تاريخها إلى الألفية السابعة قبل الميلاد.
أ/3- سرعان ما دخلت العمارة بمظاهرها الخارجية وتمثيلاتها المادية مجال "الفن" لتصبح موضوعا لنشاط فني بالمعنى الدقيق للكلمة، حيث يشكل الشعور بالترتيب والإبداع عنصرا أساسيا. ومع ذلك، فقد استمر في احتضان تخصصات أخرى تنتمي إلى الفنون الجميلة مثل النحت والتمثيل التصويري. ويعد هذا التوليف أحد النماذج الأكثر تمثيلا في العمارة الإسلامية. ولكي نقتنع بهذا، يكفي أن نتأمل قصور الأمويين التي تقدم لنا مشهداً من التماثيل الملونة وغير الملونة، تتخللها تصاميم الفسيفساء الملونة. وتظل هذه العناصر المعمارية ظاهرة بوضوح في القصور مثل قصر الهير، وقصر المشتى، وقصر المفجر، وقصر عمرة.
ب- البناء والعمارة
ب/1- عندما يتعلق الأمر بدراسة الفن المعماري الإسلامي، فمن المهم الاتفاق على المفاهيم الأساسية لهذا الفن. على الرغم من أن البناء والهندسة المعمارية مفهومان مربكان، إلا أن هناك تخصصات أكاديمية تميز بوضوح بين الفن المعماري وتكنولوجيا البناء. ومن هنا نعرف البناء بأنه طريقة تصميم المباني المخصصة لتحقيق وظيفة اجتماعية معينة، مثل السكن والعبادة والدراسة والرعاية الطبية والاحتفالات. تتطلب ممارسة البناء معرفة مؤكدة بخصوصيات البيئة ومواد البناء وقدرتها على أداء وظيفتها في ظروف الراحة والأمان. ومن المهم أيضًا معرفة المخططات الحضرية التي تنظم فضاء المدينة، حتى يتم دمج المباني المراد تشييدها بشكل متناغم.
تتميز العمارة الإسلامية بأنها تعطي الأولوية للداخل على الواجهة الخارجية. وهكذا تم تزيين الفضاء الداخلي بزخارف غنية تزين الجدران والأعمدة والكورنيش والركائز والنوافذ والأبواب والنوافير والحدائق والأحواض التي تنبعث منها روائح الزهور والياسمين العطرة. يتم زراعة أشجار البرتقال وأشجار الليمون والكروم هناك بكثرة بحيث يوفر المسكن مظهر الجنة الحقيقية. ويشهد لهذا الحديث: «جنة أحدكم داره».
ب/3- يهتم المهندس المعماري في المقام الأول بتصميم الشكل والعناصر الإنشائية للمبنى، وفي هذه الحالة الأعمدة والقباب والقباب والأقبية. لقد رافقت العمارة تطور المجتمع وأنظمة المدن الحديثة. وكان لظهور مواد جديدة مثل الأسمنت والمعادن والزجاج أثر حاسم على تطور العمارة الحديثة، الأمر الذي لم يفشل في أن ينعكس في هندستنا المعمارية.
ج- لغة ومفردات العمارة الإسلامية
ج/1- جاءت الثقافة المعمارية الإسلامية على يد البناء التقليدي الذي أطلق العنان لخياله وحشد خبراته وانتمائه الاجتماعي والديني لممارسة مهنته. بدون أي تعليم نظري، أسس هذا الماسوني نفسه من خلال عبقريته كمدرسة ومرجع للأجيال القادمة.
ج/2- ومع الطفرة الثقافية وسيطرة اللغة العربية، لغة القرآن الكريم، على اللغات المحلية المختلفة، ظهرت الحاجة إلى الشروع في توحيد هذه المصطلحات المختلفة. ومن هذا المنطلق اتخذت المعاهد اللغوية الخطوات اللازمة. وقد تبنت المعاهد المعمارية هذه المصطلحات الموحدة التي تهدف إلى كشف أساسيات الفن المعماري وتطبيق شبكة قراءة واحدة عليها، وبالتالي ضمان وحدة الهوية المعمارية الإسلامية.
د- خصائص الفن المعماري الإسلامي
د/1- على الرغم من أن البناء والعمارة يشيران إلى مفهومين متميزين، إلا أن الفن المعماري الإسلامي يتميز بخصائص عامة، ويدور حول فئتين من المبادئ، المبدأ المعماري العلمي والمبدأ الفني والإبداعي.
وفي مصر وبلاد ما بين النهرين، كما في الهند والغرب، استنفدت نظرية العمارة جميع موضوعاتها. لقد تم إثراء الكتب المخصصة لتاريخ العمارة بأطروحات حول نظريات العمارة. وهذه المراجع، التي تعد موضع دراسة للمتخصصين من كافة أنحاء العالم، وصلت إلينا في شكل نصوص مترجمة لا يوجد فيها أي ذكر لخصوصيات العمارة الإسلامية. ومن ثم كان من الضروري سد هذه الفجوة من خلال كمية معينة من البيانات.
د/2- ومن المهم أن نوضح أن الفن المعماري الإسلامي يسبق أي توجه فكري يهدف إلى تحديد خصائصه الخاصة مسبقاً. وبعبارة أخرى، تم أخذ هذه العناصر مباشرة من المعالم التي تمثل هذا الطراز المعماري. هناك، مع ذلك، سمة واحدة ساهمت في تشكيل معالم الفن المعماري الإسلامي، بل وأعطته طابعه الإسلامي. وهذا هو البعد الديني الذي تخلل الجماليات والفنون والعمارة الإسلامية.
د/3- إن العمارة والدين الإسلامي يشتركان في أنهما مستمدة من العقيدة والتقاليد والتقاليد الإسلامية الموحدة. التوحيد هو الاعتراف بوجود إله واحد لا مثيل له، ﴿وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ (الإخلاص، الآية 4). فهو إله العالمين، إله السماء والأرض. يختلف الفهم التوحيدي للألوهية عن فهم الديانات والمعتقدات الأخرى التي لديها رؤية مجسمة ونسبية لله.
بحسب العقيدة التوحيدية فإن المطلق هو موضوع بحث وإيمان دائمين بمجموع الممارسات الحضارية التي تهدف إلى توضيح سر المطلق وقواه اللامحدودة والتي تتجلى في المخلوقات والطبيعة.
د/4- أول بناء أقيم على مبدأ التقوى، وكان المسجد ملتقى لجميع المؤمنين للتأمل أمام جلال المطلق، والتأمل علناً أو سراً في سر هذا المبدأ الأبدي. وقد كان تصميم المسجد خاضعاً لقواعد الصلاة.
وبدوره، كان الإيمان بالإله المنقذ والمنقذ هو الذي حدد التكوين المعماري للمباني الأخرى مثل المدرسة، والضريح، والقصر، والمنزل.
د/5- وقد بيّن الزركشي بالتفصيل الأصول التي ينبغي أن تحكم طريقة بناء المساجد.
وكان على المؤمنين أن يصلوا في جو هادئ ويتبعوا عظة الخطيب دون صعوبة. وتشمل هذه المبادئ ما يلي:
1- ترابط صفوف المؤمنين.
2- عدم وجود أعمدة داخل المسجد من شأنها أن تخل بترتيب صفوف المؤمنين في وضعية الصلاة.
3- ضرورة الوفاء بضرورة تتابع الصفوف بإزالة كل ما من شأنه أن يخل بهذا الترتيب.
4- وجود فتحة في الحائط تفصل السور عن الحرم.
5- أن لا يكون الوصول إلى سور المسجد مباشراً.
د/6- وقد ذكر الكوكباني في كتابه (حدائق التمام في الكلام عن الحمام) وهو رسالة في الحمامات العامة، معايير النظافة والخصوصية والصحة التي يجب أن تتوفر في هذه الأبنية، وذكر أن هذا هو أضمن طريق لمنح الحمامات العامة وظيفة النظافة وعلاج بعض الأمراض. ويوجد أيضًا تقديم الخدمات من خلال إنشاء نظام إداري وتجهيز غرف تغيير الملابس والقبو والخزائن. وتذكر المعاهدة أيضًا القواعد المعمارية التي تحكم بناء الحمام العام على مستوى مرتفع، وتخطيط أنابيب المياه، وتكاثر الفتحات المصنوعة في القباب لضمان إضاءة أفضل للحمام.
علاوة على ذلك، يجب تقسيم الحمام إلى ثلاثة أقسام تتراوح من البارد إلى الساخن الجاف إلى الفاتر. يهدف هذا الترتيب إلى حماية مستخدمي الحمام من التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة.
د/7- أن تكون المنشآت الصحية مستوفية للمعايير التي يضعها القائم على إدارة الأحواز والسوق ومتوافقة مع خطة إنشائية محددة.
د/8- بالإضافة إلى المعايير المتعلقة بعمارة المباني هناك شروط أخرى يجب أن تتوفر في مخطط التخطيط الحضري. وكان الخليفة عمر بن الخطاب أول من وضع هذه المعايير، ومن أهمها ما ذكره ابن رامي في أحد كتبه. وقد أدى ذلك إلى إرساء استخدامات الأراضي العقارية وحقوق الارتفاق واستخدام الطرق.
علاوة على ذلك، نجد في كتب الجغرافيا وقصص الرحلات ذكرًا لمعايير تتعلق بالتخطيط الحضري. ومن بينها كتاب "تاريخ مكة" لمؤلفه الأزركي، و"تاريخ دمشق" لابن عساكر، و"تاريخ بغداد" للخطيب البغدادي، و"كتاب المؤشرات والاعتبار" للمقريزي الذي وصف فيه المخطط العمراني الكامل لمدينة القاهرة. وقد وصف المقريزي في مؤلفه "المساجد والحدائق والزوايا والمستشفيات والحمامات والمقاهي، مبيناً موقعها على خريطة القاهرة".
ولهذا السبب يعتبر كتاب المقريزي أفضل مرجع في علم تخطيط المدن، وبخاصة وصف القاهرة.
هـ- البعد الإنساني:
هـ/1- يشبه ابن قتيبة السكنى بالعادة. كما أن الثوب مصنوع ليتناسب مع من يرتديه، فكذلك المسكن مصنوع ليتناسب مع ساكنه. ومن ثم فإن ابن قتيبة هو أول من أثار فكرة البعد الإنساني في العمارة الإسلامية.
هـ/2- لقد أثبت البعد الإنساني نفسه في علاقته بالمنطق الرياضي الذي حكم الفن المعماري الغربي منذ الرومان والإغريق إلى العصر المعاصر.
العظمة الرياضية تعني إتقان النظام الذي تم إنشاؤه بمساعدة التركيبات والأدوات الهندسية والرياضية مثل المسطرة والبوصلة. في المقابل، تعتمد العمارة الإسلامية على مبدأ التفاعل العضوي بين الإنسان وبيئته المناخية والاجتماعية، ومعتقداته ورمزيته.
في عمله يستخدم البناء ذراعيه ويديه وأصابعه والخيط الذي يستخدمه لقياس أطوال وأقطار الدوائر عند بناء الأقواس والقباب والأقبية. يتم استخدام نفس السلك للتحقق من عمودية المبنى. إلى جانب ذكائه، اعتمد البناء على حدسه في تصميم وزخرفة وبناء وتدعيم المبنى.
وكان يهتم أيضًا براحة الساكن واحتياجاته العائلية والاجتماعية وشخصيته النفسية وقدرته على الدخول في انسجام مع بيئته. وفي هذا الصدد أشار القرآن الكريم إلى المكانة المركزية التي يجب أن يحتلها الإنسان في بيئته: ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيۡلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمۡسَ وَٱلۡقَمَرَۖ وَٱلنُّجُومُ مُسَخَّرَٰتُۢ بِأَمۡرِهِۦٓۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَعۡقِلُونَ ﴾. "هذه كلها أدلة ملموسة لمن يسمع صوت العقل" (النحل، الآية 12).
هـ/3- وفي العمارة الإسلامية يتبين مفهوم البعد الإنساني بما يتناسب مع الظروف المناخية والعادات وجوهر الحضارة الإسلامية. ليس من السهل استيراد عناصر من هذا البعد للتأقلم مع سياق مختلف عن بيئتها الأصلية. كما أنه من غير الممكن تطبيق القياسات الهندسية والرياضية في تحليل ودراسة الفن المعماري الإسلامي. وفي الواقع، يتم بناء كل مسكن بما يتناسب مع البيئة التي يعيش فيها ساكنها، مع تاريخها، ومعتقداتها، وحضارتها، وثقافتها الإسلامية.
هـ/4- إن امتلاك العمارة الإسلامية لهذا البعد الإنساني لم يمنعها من أن تتحلى بالمنطق العلمي والرياضي. وفي الواقع، ساهم المسلمون في تصميم المبادئ الرياضية الأساسية التي تحكم تشييد المباني. كان الخوارزمي من أوائل العلماء الذين طوروا الحساب العددي وتحديد مواضع الأرقام. هو من اخترع الصفر وأسس علم الخوارزميات الذي يحمل اسمه.
وفي رسالته الجبر والمقابلات قدم المعادلات الأساسية في الجبر. كما نجح أبو كامل شجاع بن أسلم، العالم المصري المتوفى سنة 240 هـ (951 م)، في حل معادلات ذات خمسة مجهولات. باعتباره عالم رياضيات، أجرى ثابت بن قرة أبحاثه حول الأحجام المكعبة والأشكال المربعة. وأما أبناء موسى بن شاكر فقد ألفوا كتاباً أسموه "كتاب معرفة مساحة الأشكال الهندسية".
وبدوره، اهتم ابن الهيثم بمسائل هندسية أكثر صعوبة، ومن بينها المثال التالي: "إذا قطع مستقيم مستقيمين آخرين وكان مجموع الزوايا الواقعة على نفس الجانب أقل من مجموع زاويتين قائمتين، فإن المستقيمين الممتدين إلى ما لا نهاية سوف يتقاطعان في الاتجاه المعاكس عند الزوايا التي يكون قياسها أقل من مجموع الزاويتين القائمتين".
هـ/5- في العمارة الإسلامية يتجلى المبدأ الأساسي للبعد الإنساني من خلال حماية الفرد من سوء الأحوال الجوية والتلوث والتلوث الضوضائي والروائح الكريهة. وهكذا استطاعت العمارة الإسلامية أن تكيف مبانيها وفقاً لهذه الاحتياجات.
في البناء الإسلامي يعتبر السور الداخلي هو المكان الأكثر أهمية. وفي المساجد يسمى (الفناء). هذا هو الجزء من المبنى الذي يتعرض مباشرة للسماء. تطل عليه الأبواب والنوافذ الموجودة في الطابقين العلويين. هذا الفناء مقاوم لأي تيار هواء من الخارج، وهو متصل بالباب الرئيسي بواسطة دهليز متعرج، مما يمنع الهواء والرياح والدخان والغبار من الدخول إلى الداخل.
وقد أثبتت التجربة أن الهواء الداخل من الأعلى يقوم بحركة لولبية فوق الفناء دون أن يتمكن من اختراقه إلا عندما يكون الدهليز والباب الرئيسي المؤدي إلى الشارع مفتوحين. بمعنى آخر، سواء كان الهواء المنبعث من الأعلى حارًا أو باردًا، نظيفًا أو ملوثًا، فإنه لا يغير درجة الحرارة المحيطة بالفناء، ولا نقاء الهواء المتداول فيه.
هـ/6- وكما هو الحال في سور المسجد فقد تم تصميم الغرف بحيث تكون أرضيتها أعلى من مستوى الفناء أو الباحة. والسبب في ذلك هو أن الهواء البارد، الأثقل من الهواء الساخن، يبقى في مؤخرة الفناء وبالتالي لا يستطيع التسلل إلى الغرف، التي كانت محمية بعتبات عالية توضع في أسفل الأبواب. ويظهر هذا النظام بشكل أوضح في الغرف التي ترتفع أرضيتها على شكل منصة أو منصتين تعملان كعائق ثان أمام تسلل الهواء البارد.
هـ/7- حرص البناء على استخدام الحجر والطوب والخشب كمواد للعمل. تم تصميم حجم كل مادة لحماية شاغلي المبنى من البرد والحرارة في الخارج.
هـ/8- في كافة المباني كانت مياه النوافير تتدفق بأشكال متنوعة وتساهم في نظافة المنزل وتبريد الهواء أيضاً. بالإضافة إلى ذلك، تمت دراسة موقع المبنى لتلبية احتياجات التدفئة وأشعة الشمس، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع انتشار روائح الطبخ والحمامات.
هـ/9- تتميز العمارة الإسلامية بخاصية فريدة يمكن أن نطلق عليها "الداخلية". سواء كان مسجداً أو مدرسة أو أي مسكن فإن كل بناء إسلامي يحتوي على هذه الخصوصية التي تهتم بالعمارة الداخلية أكثر من الخارجية. ويبدو هذا التفضيل الواضح للهندسة المعمارية الداخلية واضحاً في المساجد المبكرة مثل الجامع الأموي في دمشق، ومسجد عقبة في القيروان، ومسجد قرطبة.
ويظهر أيضًا في المنازل والقصور. يعكس هذا الاهتمام الواضح بالمساحة الداخلية الرغبة في منح المبنى استقلالية فيما يتعلق ببيئته الخارجية. ولهذا السبب تم تزيين هذا الجزء الداخلي بشكل غني وزخرفته بأجمل الزخارف المعمارية. ومن ناحية أخرى، يتم إهمال الواجهات لأسباب مختلفة، يبقى أهمها عدم الاهتمام الواضح بأي رغبة في البذخ والتكلف.
هـ/10- كان توسع استخدام السيارة كوسيلة للنقل والتنقل هو أصل التغيير في النظام المعماري للمدينة الإسلامية.
كان من المقرر تعديل المظهر الأصلي للمباني، لإفساح المجال لكتل البناء التي تصطف على حواف الطرق التي أصبحت بمثابة المركز العصبي للمدن ومنظمًا للعلاقات الاجتماعية والاقتصادية.
يدور التنظيم الحضري الحديث حول توزيع المراكز الحضرية المستقلة في كتل من المباني مرتبة على طول الشوارع أو الحدائق المحيطة. ونتيجة لذلك، تحول التركيز من هندسة الواجهة إلى تخطيط المساحة الداخلية. والآن، تعطي الهندسة المعمارية الأولوية للواجهات والحدائق، وترى أن اهتمامها بالتصميم الداخلي يتضاءل. وبدلاً من الانفتاح على هواء الفناء النقي المعتدل كما كان الحال في السابق، أصبحت أقسام المسكن المختلفة معرضة بشكل مباشر للهواء الملوث من الخارج، فضلاً عن التأثيرات المناخية الخارجية والتلوث الضوضائي.
الآن بعد أن تم تسليم المنزل إلى فضول الجيران غير المبالي، فإن الخصوصية التي لا يمكن انتهاكها في الماضي لم تعد موجودة. لقد أدى النظام الجديد الذي فرضه توسع استخدام السيارات إلى تغيير الشكل العام للمدينة. وفي حين أعطى الطابع المعماري للمدينة القديمة نظامها وتناغمها، فقد عكس الاتجاه الجديد الأدوار من خلال إخضاع النظام المعماري لمتطلبات التخطيط الحضري.
علاوة على ذلك، أدى هذا الانعكاس في الاتجاه إلى قلب النظام الاجتماعي من خلال إزالة تأثير العادات العائلية على المظهر المعماري العام. وبعد أن تلاشى هذا التأثير، أصبحت الاستخدامات الجديدة المرتبطة بظهور عصر السيارات هي التي تشكل الآن المشهد الحضري والمعماري والاجتماعي.
ف- المبادئ الإسلامية للعمران والعمارة
ف/1- لقد أعطى الإسلام للعمارة من خلال تعاليمه وتقاليده طابعها الخاص. إن الفحص الشامل لهذه العناصر من شأنه أن يجعل من الممكن إعادة بناء الأساس النظري للعمارة الإسلامية.
وكان الخليفة الثاني عمر بن الخطاب أول من أعطى تعليمات محددة للعمارة الإسلامية. وأمر والي البصرة والكوفة بمراعاة الأبعاد التي وضعها بنفسه لعمارة الطرق والشوارع وتخطيط المنازل وارتفاعها وترتيبها الدائري حول المسجد ودار الوالي.
علاوة على ذلك، وضع الفلاسفة والمفكرون مثل ابن سينا، وابن خلدون، وابن قتيبة مبادئ مماثلة ومتساوية الأهمية في العمارة.
وكذلك الحال بالنسبة للفقهاء، مثل ابن الرامي (ت 376 هـ) الذي وضع في كتابه "الإعلان في أحكام البنيان" (5 مكرر) قواعد بالغة الأهمية في التنظيم والصحة. كما أعطى مساحة واسعة لعيوب البناء، وأشار إلى آثارها السلبية. ومن عيوبها أنها لا تحمي المبنى من تسرب الدخان والروائح والضوضاء والإشعاع الشمسي. وألزم المواطنين بعدم انتهاك خصوصية جيرانهم بسرقة رؤيتهم، كما أوصى بحماية المنزل من رؤية المارة.
ف/2- لقد ارتبط الفن والتقنية المعمارية بجوهر الشريعة الإسلامية مما منحها هويتها الخاصة عبر القرون. إلا أن تنوع العادات واللغات والحضارات التي اعتنقت الدين الإسلامي، من الصين شرقاً إلى المحيط الأطلسي غرباً، أدى إلى نشوء تنوع واسع في الأساليب المعمارية التي تجتمع حول ضرورة الوظيفة. وعلى عكس الفن اليوناني الذي أضفى طابعاً معمارياً فريداً على كافة أنواع المباني، اهتمت العمارة الإسلامية بخلق توافق متناغم بين الطابع المعماري للمبنى ووظيفته. ونتيجة لذلك، أصبح المسجد، والمدرسة، والمقبرة، والمستشفى أو المنزل، كل واحد منهم لديه هيكله المعماري الخاص. إن مجرد النظر إلى الجزء الخارجي لأي مبنى يكفي لإخبارنا عن وظيفته. والأفضل من ذلك أن قيمة المبنى تُقيَّم حسب مدى تكيفه مع الوظيفة الموكلة إليه. لذلك، فإن أي مبنى يستوفي معايير الهدوء والأمان يعتبر ملائماً. تحدث ابن قتيبة عن الشروط التي يجب أن تتوفر في كل بناء، سواء كان خيمة أو بناء مبنياً. وتحدث أيضًا عن المباني المصنوعة من الجبس، والمباني ذات الأشكال المبسطة والمتوجة بالقباب، والمنازل ذات الجدار الاحتياطي الذي يرفع السقف. وقد أطلق على كل غرفة اسماً خاصاً يتناسب مع وظيفتها، مثل الفناء، والسياج، وغرف النوم، والإسطبل المخصص للإبل، والمراحيض. وأكد أيضاً على أهمية مواد البناء باعتبارها ضماناً لسلامة ومتانة البناء.
ف/4- تعتبر العلاقة بين العمارة والتخطيط الحضري أحد المبادئ الأساسية في نظرية العمارة الإسلامية. ومن النادر جدًا أن يصف الجغرافيون أو الرحالة أو الشعراء عناصر العمارة دون تحديد عناصر البيئة الحضرية العامة التي تضم هذه المباني.
ز/1- في كثير من المدن الإسلامية مثل أصفهان ودبي وحلب كان هناك نظام تهوية وتكييف هواء كان جزءاً من مخطط البناء الأصلي المعروف باسم "بادغير". يتكون هذا النظام من برج يرتفع فوق المبنى، مزود بنوافذ مثقوبة من الأعلى ومقسمة بحاجز مرتب على شكل قطري.
كان هذا البرج يستخدم لإدخال الهواء الخارجي إلى الغرف بعد مروره بحوض ماء يشبعه بنضارته.
G/2- نظام تهوية أبسط يتكون من إقامة حواجز توضع في أعلى الأبراج، حيث يتم عمل فتحات أفقية لالتقاط الهواء الخارجي المخصص لتبريد الأشخاص المستيقظين أو النائمين الذين يشغلون شرفة المبنى.
ز/3- تم اكتشاف نظام تهوية في بعض المباني الأثرية يقوم مبدأه على استخدام أنابيب مرتبة أفقياً وتستخدم لتوزيع الهواء القادم من الخارج بين غرف البناء. كانت تستخدم النوافذ الشبكية عادة لالتقاط الهواء الخارجي.
ز/4- يظل "الملقف" هو نظام التهوية والتكييف الأكثر كفاءة في المباني الإسلامية التي تقام غالباً في بيئة جافة وحارة. إنه نظام غير مكلف ونظيف يحتاج إلى إعادة تأهيل في منازلنا الحديثة، ليس كأداة زخرفية جمالية كما هو الحال في جبل علي في دبي، ولكن كعنصر بناء له وظيفة صحية واقتصادية.
ح- العمارة والزخرفة
تُعد الزخرفة واحدة من أبرز السمات المميزة للفن المعماري الإسلامي. صحيح أن المسجد النبوي، أول بناء في تاريخ الإسلام، بني على طراز بسيط ورصين، إذ يتكون ببساطة من سقف مصنوع من جريد النخيل ومثبت على جذوع النخيل.
كان هذا المسجد في الأصل خاليًا من أي زخارف، ثم أصبح موضوعًا لترميم أمر به الوليد بن عبد الملك لوالي المدينة المنورة عمر بن عبد العزيز. تم تنفيذ هذا العمل على أسس معمارية جديدة تعتمد على كثرة الزخارف والفسيفساء، على غرار ما تم تنفيذه في مسجد دمشق. وفي الكتاب الذي خصصه لهذا المسجد أعطى العالم الفرنسي سوفاجير وصفاً مفصلاً له ورسم الزخارف التي تزينه.
ح/2- يستلهم فن البناء الإسلامي من الخطط المصممة وفق التقاليد الإسلامية الأصيلة وبما يتفق مع متطلبات الوظيفة. ويعتمد أيضًا على إنشاء أنماط زخرفية مستوحاة من الزخارف الزهرية أو الهندسية أو الخطية. لقد تطورت تقنيات الزخرفة إلى حد أنها أدت في النهاية إلى إخفاء الخطة نفسها. ويظهر غلبة الزخرفة في مسجد قرطبة، وبخاصة في القسم الذي أقامه عبد الرحمن الداخل، على غرار المسجد الأقصى والمسجد الأموي في دمشق. وقد خضع المظهر الخارجي لهذا المسجد بعد ذلك لتعديلات ثرية. وفي عام 848م قام عبد الرحمن الثاني بتوسيع المسجد بشكل عميق بلغ نحو ستة وعشرين متراً. وفي عام 965، أمر عبد الرحمن الناصر بدوره بتوسيع الجهة الجنوبية للمسجد، فاستكمل مسجد عبد الرحمن الداخل الأول وجامعه بأكمله. إن هذا التتابع من التوسعات يشهد على هيمنة الزخارف المتزايدة والتي انتهت إلى التغلغل حتى المحراب. وبذلك فإن محراب المسجد الواقع في قسم الحكم يعد من أجمل نماذج الزخارف الإسلامية. تضاف إلى هذه التحفة الفنية الرائعة قباب نفس القسم، والتي تعتبر بدورها جواهر حقيقية من فنون الزخرفة الإسلامية. وبأمر من الحاجب المنصور، تم البدء في توسعة ثالثة سنة 992م على طول المسجد من الجهة الشرقية.
إن تطور الزخارف التي تزين التيجان والأقواس والقباب في الأقسام المختلفة لمسجد قرطبة يوضح بشكل واضح التأثير القوي والمتزايد للزخرفة على العمارة الإسلامية.
ح/3 – تعتبر الزخارف العربية، والتي تسمى بالزخارف العربية، من أكثر الزخارف تمثيلاً لروعة الفن المعماري الإسلامي. ومع ذلك، وبسبب هيمنة هذه الزخارف العربية على العناصر المعمارية الأخرى، ولا سيما في قصر الحمراء في غرناطة، فقد انحصرت الهندسة المعمارية في الجانب الزخرفي المحض.
ح/4- ومن أبرز عناصر الإبداع المعماري النقوش الخطية التي تزين أسقف المباني الإسلامية. بالإضافة إلى الأهمية الجمالية التي تقدمها، فإن هذه الكتابات تعتبر شهادات تاريخية حقيقية لتطور العمارة الإسلامية. ولا تزال أقدم هذه العينات تزين حواف قبة قبة الصخرة إلى يومنا هذا.
تحتوي القبة على آيات قرآنية مكتوبة بالخط الكوفي، ومرصعة بقطع من الفسيفساء تزين القبة، وهذه النقوش تجعل من الممكن إعادة بناء السياق التاريخي الذي ميز بناء القبة. يكاد لا يوجد مبنى إسلامي يخلو من نقوش محفورة على الحجر أو الخشب أو منفذة بقطع من الفسيفساء والتراب.
وتشكل الآيات القرآنية الموضوع الرئيسي لهذه الكتب المقدسة. تحتوي أحدث المباني على نصوص من هذا النوع تروي صفات الباني ومساهماته في أعمال البناء. علاوة على ذلك فإن هذه الكتابات هي تفاصيل تاريخية تسمح لنا بتتبع تطور الخط العربي منذ نشأته حتى ظهور الخط الكوفي والخط المنتشر المسمى بالتولوت.
وتوجد جواهر أخرى من الخط العربي التقليدي المصور أو الذي يشبه الشطرنج في المساجد الفارسية والمملوكية والعثمانية.
أ- الوحدة والتنوع في العمارة الإسلامية
1/1- إن الوحدة من أهم سمات الفن المعماري الإسلامي، وهي تتجلى في أماكن العبادة، والمساكن الحضرية، وفي جميع أنواع المباني العامة أو الخاصة، متجاوزة بذلك الحدود المكانية والزمانية.
وفي واقع الأمر، تظل الوحدة هي محور الهوية الفريدة للعمارة الإسلامية. ورغم أن المباني الإسلامية في الصين انحرفت عن هذه الوحدة، إلا أن تنوع الأساليب المعمارية الممتدة من إندونيسيا إلى المغرب يشهد على هذه الوحدة. والأفضل من ذلك أن أماكن العبادة الإسلامية في أوروبا، في باريس أو لندن أو ميونيخ، احتفظت بخصوصيات هويتها.
وبعبارة أخرى، حيثما وجد الإسلام أو كان المسلمون يشكلون الأغلبية، فقد وجدت الهوية الإسلامية دائما أحد أبرز تمثيلاتها في الهندسة المعمارية.
1/2- إن تنوع الأساليب المعمارية يقدم دليلاً على المساهمة الغنية للإبداع في التصميم المعماري. ويعبر أيضًا عن التناغم والانسجام بين العمارة والبيئة الحضرية والاجتماعية والثقافية المحيطة بها. ويعد التنوع في الوحدة أحد السمات المميزة للعمارة الإسلامية التي تساهم في تطوير العمارة الحديثة التي تجمع بين الأصالة والانفتاح على التغيير والإبداع.
1/3- يتميز الفن الإسلامي بشكل عام والعمارة بشكل خاص بتنوع الأساليب والأشكال وهو ما يفسره التدابير المشجعة للقوة القائمة وقوة التفاعل مع الثقافات والبيئات الأخرى.
ومع ذلك، فإن الوفرة الشديدة في الأساليب هي نتاج الحرية الإبداعية التي يتمتع بها الفنان والمهندس المعماري.
لقد دعا الإسلام دائما إلى الفعل المسؤول، كما أوصى بتنمية الذوق الجمالي، والجمع بين الجمال والكمال. وقد وضعت المبادئ الأساسية في القرآن الكريم: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ (الأنعام، الآية 164) و ﴿وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُۥ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (التوبة، الآية 105).
وبالإضافة إلى ذلك، فقد كلف الله الإنسان بإعمار الأرض فقال له: (ولقد عرضنا على الأرض والسماء الوديعة). لكنهم رفضوا خوفا من ثقل هذه المسؤولية، فوافق الإنسان على تحملها. ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ (الأحزاب: 72). إن هذه الآية القرآنية تبين لنا مدى المسؤولية الملقاة على عاتق الإنسان، وتوضح لنا مدى الحرية التي أعطيت له. اثنان من الموارد التي تفوق بكثير القوة المنسوبة إلى السماوات والأرض والجبال. إن هذه القوة غير العادية التي يمتلكها الإنسان لابد وأن تجعله مستعداً للدخول في شركة مع أشكال أخرى من الحياة، من خلال تكريس نفسه لأعمال الخلق. وبفضل هذه الحرية الفريدة، استطاع الفرد المؤمن، حامل الوديعة الإسلامية، أن يشكل أروع الحضارات الإنسانية. لقد استمد قوته دائمًا من ثقته وإيمانه العميق بالله، مما جعله يسعى نحو هدف أسمى. إن تجاهل الإنسان للطاقة التي يتعين عليه أن يبذلها لتحقيق هذه الغاية النهائية، يُظهر بذلك أنه ظالم لنفسه وغير مدرك على الإطلاق للمهمة التي تقع على عاتقه.
وتتجلى هذه المسؤولية من خلال البناء الحضاري الضروري الذي يشمل كافة قطاعات الحياة: العلم والقانون والعمارة والفن. فيجب على كل مبتكر أن يجعل القرآن الكريم مصدر إلهامه الرئيسي. عليه أولاً أن يلتزم بالوصايا القرآنية التي أعطته حرية واسعة بالتأكيد ولكنها ليست أقل مسؤولية. حينها سيكون قادرًا على الاهتمام بالاحتياجات المتغيرة لمجتمعه، مثل الوضع الاجتماعي والذوق والأنواع الفنية.
إذا كانت السلطة تسعى دائمًا إلى تعزيز العمارة والفن لصالح المجتمع، فإن المنافسة بين الملوك والحكام، المنشغلين برفع مستوى مدنهم، لم تخلو أبدًا من الشراسة. ولكن بالنسبة للأفراد الذين كانوا مهتمين في المقام الأول بالاستقرار والسعادة، كان لكل منهم أذواق معينة أرادوا ترجمتها إلى واقع ملموس. لقد أدى هذا التعدد في الأذواق إلى تخصيب عقل الفنان، الذي استطاع أن ينشر مهارته في حدود الحرية الواسعة إلى حد كاف، والتي تشكل جوهر الجماليات الإسلامية.
1/5- في العمارة الإسلامية، نظام التصميم بعيد كل البعد عن أن يكون مقيداً. والدليل على ذلك أن تنوع الأساليب المعمارية والفنون الإسلامية مثل العربيسك والزخرفة والخط العربي تشهد على العبقرية الإبداعية للفنان المسلم الذي يمتلك موهبة تخيل عدد لا محدود من الأشكال.وكدليل على ذلك هناك الأبنية الشامخة في أصفهان وبغداد ودمشق والقاهرة والقيروان وقرطبة. هذه المباني الفخمة هي ثمرة خمسة عشر قرنا من الحضارة الإسلامية. ولكن هذا التنوع، بعيداً عن كونه نتاجاً لتعدد الحكومات والدول، فإنه يعكس إبداع الفنان الذي يعد المؤلف الحصري لهذه الأعمال الرائعة. كان الملك الراعي أو مالك هذه التحف الفنية مجرد داعم مالي. ولهذا السبب يظل الإبداع المعماري والفني هو العمل الفريد للمبدع نفسه الذي يستثمر موهبته ومهارته لإخراج الأعمال الفنية من العدم.كما أن الروح الشخصية، المبدأ المؤسس للفن الحديث، كانت بالفعل، على مر الزمن، في قلب الحضارة الإسلامية.
 |
مسجد سيدي براهيم بغرداية
1. أنواع العمارة في الإسلام :
· العمارة الدينية :
§ المساجد: عدة نماذج للمساجد القديمة أهمها الإباضية والمرابطية ينظر المقال التالي :
§ العمارة الصوفية: ينظر الرابط :
§ المقابر: ينصح بقراءة الرابط :
Épitaphes du cimetière d’al‑Bawwāba ou de Bāb Allāh du Mīdān à Damas
v العمارة المدنية :
-القصور:الاطلاع على المقال المهم :
صناعة البناء عند الحماديين –قصور القلعة نموذجا | ASJP
-الحمامات :يُنظر
الحمّامات التقليدية ضمن النسيج العمراني للمدينة الإسلامية، دراسة مقارنة في عدة مدن متوسطية

العمران الصوفي من الرباط إلى الضريح
العمران الصوفي من الرباط إلى الضريح
-نفيسة دويدة :المعتقدات والطقوس الخاصة بالأضرحة في الجزائر خلال الفترة العثمانية.
- Yosr Malek ; Le patrimoine architectural maraboutique : institution, spatialité et symbolique.
- Mavluda Yusupova ;L’évolution architecturale des couvents soufis à l’époque timouride et post-timouride.
مثل الخانقاه أولى المباني الدينية المختلفة عن المسجد او الجامع وقد احتل مكانة فريدة في العمارة التيمورية الرائعة. وهي تشكل، في الواقع، النوع الرئيسي من الملجأ الصوفي في آسيا الوسطى، على الرغم من وجود أنواع أخرى: الرباط والتكية، ونزل الصوفيين، وفي العديد من البلدان الإسلامية الأخرى، الزافية.
لم يتم بعد دراسة نشأة وخصائص هذه الأنواع المختلفة من الملاجئ بشكل كافٍ، وقد أدت بعض المحاولات للتمييز بين الوظائف والهندسة المعمارية إلى وصول الباحثين إلى استنتاجات متناقضة.
لم تكن عمارة الملاجئ الصوفية في آسيا الوسطى موضوع دراسة محددة حتى لو تناولها بعض المؤلفين في ملخصاتهم أو في الإطار العام لأعمالهم. وهكذا، قام في إل فورونينا بتحليل هندسة الخانقاهات الأكثر شهرة في آسيا الوسطى. اقترح ج.أ.بوجاشينكوفا3 باختصار تصنيفًا للخانقاه الرئيسية في آسيا الوسطى وخراسان في القرنين الخامس عشر والسادس عشر، ثم اقترح ل.جو.مانكوفسكاجا4 تصنيفًا آخر للملاجئ الصوفية المعروفة في آسيا الوسطى بناءً على خطتهم.
بالإضافة إلى قراءاتنا، سمح لنا البحث الشخصي في الأرشيف وفي الميدان بإكمال المعلومات المقدمة بالفعل وتصحيحها في بعض النقاط. وعلى هذا الأساس حاولنا تحديد طبيعة ومراحل تطور الملاجئ الصوفية، والتحول على مر القرون في وظائفها، وكذلك توضيح الأسئلة المتعلقة بوجود وأهمية مصطلحات آسيا الوسطى: الرباط، الخانقاه. والزافية والتكية.
في الجزء الأول من هذا المقال، سنعرض بإيجاز تصورنا لتاريخ تكوين الملاجئ الصوفية ومسألة مصطلحاتهم، وفي الجزء الثاني، سنحلل خانقاه التيموريين وما بعد الخجول.
يبدو لنا أن تطور عمارة الملاجئ الصوفية يمكن تقسيمه إلى أربع فترات، ترتبط كل منها بتطور الصوفية نفسها.
⦁ الرباط
كانت الرباط في الأصل حصونًا عسكرية وتبشيرية عربية، وقد تحولت تدريجيًا بمرور الوقت إلى مباني تجارية أو فندقية في الأساس، تسمى الخانات، أو في حالات نادرة، إلى رباط للصوفيين. وفي وقت لاحق، اعتبارًا من القرن التاسع، في آسيا الوسطى، تم بناء رباطات خاصة للصوفيين. على سبيل المثال، نعلم أنه كان هناك واحد في نصاف بفضل المعز بن يعقوب، وأيضاً اثنان في سمرقند – المربع، تم بناؤهما في عهد إسماعيل السماني (القرن التاسع) والأمير (القرن الحادي عشر)، بالقرب من مدرسة تمجاش خان8. المصادر المكتوبة فقط هي التي تسمح لنا بالقول إن الرباطات في آسيا الوسطى، خاصة بين القرنين التاسع والثاني عشر، لعبت دور نزل للصوفيين. يمكننا أن نفترض أن مخطط كل هذه المباني تم تنظيمه حول فناء لأنه مرتبط عضويا إلى الرباط العسكري والخانات التي كان لها نفس الهيكل.
⦁ الخانقاه
في الأصل، كانت هذه أماكن لمرور الصوفيين. هذا هو المكان الذي تجري فيه الطقوس الدينية المجتمعية والمناقشات وأحيانًا التدريس. منذ نهاية القرن العاشر، تحولت الخانقاه، مع احتفاظها بوظائفها القديمة، إلى مراكز صوفية مع مركز للدراسة تم تشكيله حول المعلم (بير) وتلميذه (موريد).
في الفترة الأولى، تعايشت عدة أنواع من الخانقاه، مما يجعل من الصعب تطوير تصنيف دقيق. نجدهم مذكورين لأول مرة باسم الخانقاه المانوية (في سمرقند) والكرامية، في مطلع القرنين التاسع والعاشر في مافارانهر وخراسان. من المحتمل أن جميع هذه الخانقاه كانت تشبه المباني الرهبانية، حيث تم تنظيم المباني حول فناء داخلي. غالبًا ما يتم إنشاؤها بالقرب من قبر الصوفي الموجود مسبقًا، وعلى العكس من ذلك، في منزل الشيخ المؤسس الذي دُفن بالقرب منه عندما توفي. وهذا هو حال الخانقاه وضريح أبي سعيد في مخانة (القرن الحادي عشر)، الواقعين مقابل بعضهما البعض، وخانقاه حكيم محمد الزيموني (توفي ١٠٢٥)، الواقعان مقابل شارع سوف في بخارى. من المفترض أن خانقاه زيموني هي المنزل السابق لهذا الشيخ وأن الضريح المقبب هو شلاخانته السابقة حيث اعتزل.
- الزاوية ،وفي الأصل، كانت الزاوية عبارة عن غرفة تقع في المسجد أو في مكان قريب، حيث يتم تدريس القرآن والقراءة. خلال الفترة الأولى، أصبحت موطنًا للصوفية، حيث كان يصلي ويعلم مريدين. تخبرنا وثائقنا أن مصطلح الزافية كان يستخدم في آسيا الوسطى بشكل رئيسي من قبل الأجانب (مثل ابن بطوطة في القرن الرابع عشر).
الشكل 5: خانقاه قاسم الشيخ، كرمينا، القرن السادس عشر.
الشكل 7: خانقاه ومسجد مجمع شار بكر بالقرب من بخارى، القرن السادس عشر
الشكل 8: خانقاه مجمع شاربكر، بالقرب من بخارى، غطاء الغرفة بأربعة أقواس متقاطعة، القرن السادس عشر.
منمنمة لخنقاه في الفترات المتاخرة
رباط المنستير بتونس
• زوايا الغرب الإسلامي
ظهرت أولى المنظمات الإخوانية حول الرباط. يعتبر رباط المنستير، الذي تأسس سنة 796 ميلادية (180 هجرية)، أقدم تجمع أخوية في شمال إفريقيا ، يفقد الرباط تدريجيا دوره العسكري، ويشار إليه بدلا من ذلك على أنه مكان للاعتزال والتعبد. وفي الوقت نفسه، يتم إعادة تفسير الجهاد بمعنى باطني: القتال الداخلي ضد الذات. ثم أُعلن عن تطور بظهور مؤسسة الزاوية كبديل للرباط.
منذ القرن الثاني عشر، بدأت العديد من الزوايا في ترسيخ نفسها في النسيج الحضري المغاربي وانتشرت مع تزايد تأثير الأخويات الدينية في هذه المنطقة .. ومن خلال وضع نفسها في أعلى التسلسل الهرمي، فإن أماكن التعبير عن العقيدة الصوفية ستمثل نفسها كأقطاب للهوية الإقليمية. وبعد ذلك، تطورت على مساحات شاسعة، وجمعت معًا مجموعات سكانية لها نفس الحساسية.
ففي الغرب الإسلامي نستخدم أيضًا في كثير من الأحيان مصطلح "سيدي" أو "لالة" و"سيدة" التي تنسب إلى النساء لتعيين شخصية مقدسة. والأخيرة تبث "بركة " مما قد يكون حافزا لتعلق الحجاج بالحج
الممارسات من أجل التغلب على التوترات الاجتماعية ومظاهرها وانعكاساتها المختلفة . لقد دُعي القديسون إلى تقديم العديد من الشكرات والفوائد وبالتالي لعب أدوار اجتماعية ودينية. تم الحصول على قوى التوماتورجيكا والحماية والشفاء والرعاية من الأفراد الذين يمثلون قنوات الكرامات (المعجزات). يوضح مثال مقام "سيدي الميزري" كيف عملت أيديولوجية البركة والتبجيل الجماعي للأولياء في بيئة محددة وشكلت تكوينها الاجتماعي والثقافي والأخلاقي.
تركز الزاوية وتثبت تمثيلات المرابطية، وبالتالي تشكل الإطار المميز لممارسات الطاعة الروحية الصوفية. يتم تعريفها أولاً على أنها الممارسة الأساسية لطقوس الأخوات الصوفية التي لها جانب عقائدي وجانب خارجي. الميتافيزيقا الصوفية هي في قلب النظام. وهذه الطقوس التي محل التعبير عنها الفضاء المرابطي، متعددة الأوجه.
تشير الطقوس إلى الطريقة التي يحدد بها الأفراد انتماءاتهم الثقافية من خلال نظام فريد من التمثيلات المكانية والزمانية، وتشير الممارسات بشكل أو بآخر إلى ما يحدد السلوك الاجتماعي.
⦁ عمارة الزاوية: التركيب المعماري والتوزيع المكاني
إن شكل الكمامة الذي يتكون من قبة ترتكز على حجم مكعب هو مفهوم تقليدي قديم تم دمجه في العالم الإسلامي. وقد استعادها وتكيفها الباطنية الإسلامية، وهي تجسد في أشكالها الجمع بين المربع والدائرة. وهكذا تمثل الزاوية، في العديد من التعبيرات الممكنة، بنية نموذجية تتكون من فناء وقبة على قاعدة مربعة. وتوضح زاوية "سيدي المزري" بالمنستير هذا التصنيف جيدًا .
تتكون أي زاوية عمومًا من رواق مدخل يسمى سكيفا يطل على الفناء، وغرفة صلاة بالمسجد، وغرفة مقببة تغطي الغرفة الرئيسية المربعة الشكل وتتميز بوجود قبر ولي - يحمل اسمه - ذريح، غرفة أو أكثر لقراءة وتلاوة القرآن الكريم. وفي بعض الأحيان نجد مساحة مفضلة لحالة العزلة وهي الخلوة .
⦁ رواق المدخل: السقيفة
يقدم مكتب الاستقبال الذي يذكرنا بالسقيفة مساحة انتقالية توضح المدخل والفناء. وهذا الرواق الذي يمر من تحته الصوفي يرمز إلى الطريق، أي الفضاء الذي يمر من خلاله الصوفي لينتقل من العالم الزمني إلى العالم الروحي من خلال تذكر واستحضار النظام الإلهي. ومن خلال الممارسات الروحية التي توجهه نحو المركز (العقل)، يتجه الصوفي إلى الداخل ويبدأ بالخروج من العالم المادي الذي هو منغمس فيه. تموت النفس، وعندما تموت تترك الجسد روحيًا وتذهب بحثًا عن الروح. فهو يصف الطريق إلى التنوير الذي يؤدي، بحسب ابن عربي، إلى معرفة اليقين . ولذلك يجد الإنسان نفسه في الجانب الخفي. وها هو في علاقة داخلية مع النقطة المركزية، من الجسد ومن خلال الروح.
⦁ فناء صحن
يؤدي المدخل إلى الفناء المحمي بأحد أروقته. وهذا الفناء مربع الشكل ومفتوح على السماء. ومن حوله يتم ترتيب الغرف والغرف المغطاة. الفتحة نحو السماء ترمز إلى العلاقة بين السماء والأرض والتي من خلالها يمر أ
منطقة كونية إلى أخرى وتشارك في تقديس الفضاء الذي يجسد محور العالم على جميع مستويات البناء. باسمه صحن، فهو يرمز إلى وعاء رحمة السماء التي تتجسد في المطر والماء وبالتالي الحياة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن شكل صحن السماء يذكر في الطرح شكل الكعبة. كما تتجسد هناك أيضًا أفكار المركز والمحيط، والوحدة والتعددية، والتوجه الجاذب المركزي، والاتجاهات المتقاربة. في هذه الحالة، الفناء هو شكل معارض. إنها تشكل حضوراً حضرياً، وذلك بفضل أبعادها التي تفضل ما يسميه الصوفيون التجالي حيث يكون تجلي الله محسوساً بالحواس. ولذلك فهو مكان ظاهري .
⦁ قاعة الصلاة بالمسجد وقاعة خلوة
الباب يدل على البدء والطريق. المحراب هو الهدف والغاية والمكان الذي يجب الوصول إليه. هذا هو مكان الحقيقة. ومن وجد الباب فدخل إليه وجد الطريق الصحيح. ولهذا السبب تم تزيين هذين العنصرين فقط من المبنى بأكمله. وبالتالي، فإن اختيار أبعادها وأشكالها وألوانها يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمفهوم الروحي. بالإضافة إلى ذلك، فإن الغرفة التي تعتبر بمثابة خلوة للصوفي هي مكان مقدس حيث يذكر اسم الله بصمت أو بصوت عالٍ.
خلاصة القول، يمكن أن تكون الزاوية، من خلال رمزيتها القوية، صورة روح الصوفي الذي، من خلال سعيه على الطريق، أو الطريقة، يتجاوز العالم المادي للوصول إلى الحقيقة الإلهية، الوحدة. بهدف بيان علاقتها بالفكر الصوفي،الزاوية سوف تقدم نفسهاكموضوع مركزي للقراءة الرمزية. ومن ثم فإن البعد الروحي يقع في قلب هذه الرمزية الناتجة عن التعايش الحقيقي بين المثالي والمكاني. إن فكرة الروحانية هذه، بمحتواها الديني والثقافي والفني، تقع في قلب فهم الفضاء المعماري المرابطي. مما يعني أن هذا المكان الحافل بالتجارب والمعتقدات وآثار الخيال والأبعاد الثقافية الممثلة للفرد والمجتمع يعكس تماثلا بين المفهوم الصوفي والعمارة المرابطية.
التكية : هي ما يشبه الخلوة في بلاد الغرب الإسلامي لكنها اخذت معنى هندسي اكثر دقة وتعقيدا بالشرق خاصة في العهد العثماني وهي كلنة فارسية الأصل وتتكون من قاعة داخلية واسعة تسمى الصحن. السمعخانة وهي قاعة تستخدم للذكر، والصلاة والرقص وغرف للمريدين وهي الغرف الذي ينام بها الدراويش.
غرفة استقبال لاستقبال العامة.قسم الحريم وهو مخصص لعائلات الدراويش.قاعة طعام جماعية ومطبخ.مكتبة.دورة مياه ومستحم.
• الضريح و المزار:
لضريح لغة هو الشق الذي يكون وسط القبر، وقيل هو القبر كلّه. أما اصطلاحًا فيطلق على البناء المشيد على القبر (أي فوقه). ويتميز ببساطة الشكل والتصميم عادة، فهو بين المسجد و الدور المدنية .
وتعلو الضريح في الغالب القبة التي تكبر أحيانــًا وتتسع فتشمـل الضريح، ويسمى بقبة فلان. وتمثّل بدورهـا رمـزًا ذا قداسة، وقد تكون مفتوحـة أو مغلقـة. كما تختلف أحجام وأشكال وتركيبة الضريح والقبّة على السواء، فتكون كبيرة أو صغيرة، مربّعة أو أسطوانية، رخامية أو حجرية.
ولا يقتصر الضريح على قبر واحد في مكان واحد إذ يمكن أن نجد عدة أضرحة لشخص واحد في أماكن متفرقة. ويمثل الضريح في العرف الشعبي رمز التقوى والصّلاح، وهو مكان لالتماس البركة والخير والدعاء المستجاب. وتنقسم الأضرحة إلى أنواع: منها ما يضم رفات صاحبه؛ ومنها أضرحة الرؤيا، وهي تلك التي تم تشييدها بعد رؤية أحد الأولياء الصالحين في المنام في موقع معين؛ والأضرحة "الوهمية" وهي التي لا تحتوي على رفات، وتمّ إنشاؤها تبعا لرغبات سياسية أو دينية.
وقد مثّلت الأضرحة ملجأ للغرباء وعابري السبيل، وحتى الفارين من العدالة أحيانــًا لأنها لطالما تمتعت بالحرمة والهيبة بحيث يصعب فيها اللجوء لاستعمال القوة والعنف في تنفيذ حكم ما، أو إجبار شخص غريب على المغادرة وخلاف ذلك. وارتبط الأمر بطهارة وقداسة المكان في نظر الزوار وإيمانهم بقدرة الولي صاحب الضريح على القصاص والانتقام من أي ظالم، ونذكر من ذلك مثلا هروب المزوار الحاج سعدي سنة 1829 وطلبه النجاة من غضب الداي حسين، واختبائه بضريح الثعالبي.
و اعتمد الجزائريون على الأضرحة لحل مختلف مشاكلهم واهدافهم التي يمكن تقسيمها إلى :
• صحية
تتمثل عـادة في الشفاء من الأمراض المختلفة، وتحصيل الصحة والسلامة الجسدية، وقهر الكسل والخمول. وقد يختص ضريح ما بهذا النمط .
• نفسيــة
الحصول على الراحة والهدوء الداخلي، واتقاء الشرور، وإبعاد العين والحسد، ونيل الخير والبركة، واستجابة الدعاء. وتشترك فيها تقريبــًا كل الفئات، وترتبط إجمالاً بأغلب أماكن الزيارة.
• اجتماعيــة طلب العون والقوة، طلب الحماية والأمان، تأمين حاجة الغرباء وعابري السبيل، وإبداء التكافل الاجتماعي.
• دينيــة
تتمثل في تحقيق الاستقرار الروحي والسعادة في الدارين الدنيا والآخرة، والتقرب إلى الله عن طريق وليّه الصالح.
وتخلل هذه الزيارة طقوس الاستشفاء بالشرب والاغتسال من بئر أو عين "مباركة" قد تكون تابعة للضريح، ومضغ ثمار وأوراق الأشجـار المحيطة به وشرب منقوعها مثلاأو الحصول على الخلطات والتمائم والتعازيم والأحجبة طقوس تمارس بصفة فردية كإشعال الشموع، ونشر البخـور أوإطلاق الزغاريدأو ذات طابع جماعي كإقامة حلقات الذكر والدعاء، وترديد الأوراد والمدائح والأناشيد.
وقد تكون لاهداف حربية عبر الحصول على بركة الأولياء الصالحين كما في العهد العثماني حيث صادف قيام دولة الدانمارك بهجوم بحري ضد مدينة الجزائر سنة 1771 احتفال الجزائريين بيوم المولد النبوي الشريف، ولذلك أوقدوا الشموع حتى أضاءت المدينة بأكملها، واعتقد المهاجمون أنه استعداد للمواجهة، فقصفوا المدينة إلى أن نفذت ذخيرتهم وعادوا خائبين. وقد اعتقد السكان آنذاك أن بركة الأولياء الصالحين هي التي حمت مدينتهم وقاطنيها، وتغنوا بذلك في أشعارهم.
العمران الصوفي من الرباط إلى الضريح
-نفيسة دويدة :المعتقدات والطقوس الخاصة بالأضرحة في الجزائر خلال الفترة العثمانية.
- Yosr Malek ; Le patrimoine architectural maraboutique : institution, spatialité et symbolique.
- Mavluda Yusupova ;L’évolution architecturale des couvents soufis à l’époque timouride et post-timouride.
مثل الخانقاه أولى المباني الدينية المختلفة عن المسجد او الجامع وقد احتل مكانة فريدة في العمارة التيمورية الرائعة. وهي تشكل، في الواقع، النوع الرئيسي من الملجأ الصوفي في آسيا الوسطى، على الرغم من وجود أنواع أخرى: الرباط والتكية، ونزل الصوفيين، وفي العديد من البلدان الإسلامية الأخرى، الزافية.
لم يتم بعد دراسة نشأة وخصائص هذه الأنواع المختلفة من الملاجئ بشكل كافٍ، وقد أدت بعض المحاولات للتمييز بين الوظائف والهندسة المعمارية إلى وصول الباحثين إلى استنتاجات متناقضة.
لم تكن عمارة الملاجئ الصوفية في آسيا الوسطى موضوع دراسة محددة حتى لو تناولها بعض المؤلفين في ملخصاتهم أو في الإطار العام لأعمالهم. وهكذا، قام في إل فورونينا بتحليل هندسة الخانقاهات الأكثر شهرة في آسيا الوسطى. اقترح ج.أ.بوجاشينكوفا3 باختصار تصنيفًا للخانقاه الرئيسية في آسيا الوسطى وخراسان في القرنين الخامس عشر والسادس عشر، ثم اقترح ل.جو.مانكوفسكاجا4 تصنيفًا آخر للملاجئ الصوفية المعروفة في آسيا الوسطى بناءً على خطتهم.
بالإضافة إلى قراءاتنا، سمح لنا البحث الشخصي في الأرشيف وفي الميدان بإكمال المعلومات المقدمة بالفعل وتصحيحها في بعض النقاط. وعلى هذا الأساس حاولنا تحديد طبيعة ومراحل تطور الملاجئ الصوفية، والتحول على مر القرون في وظائفها، وكذلك توضيح الأسئلة المتعلقة بوجود وأهمية مصطلحات آسيا الوسطى: الرباط، الخانقاه. والزافية والتكية.
في الجزء الأول من هذا المقال، سنعرض بإيجاز تصورنا لتاريخ تكوين الملاجئ الصوفية ومسألة مصطلحاتهم، وفي الجزء الثاني، سنحلل خانقاه التيموريين وما بعد الخجول.
يبدو لنا أن تطور عمارة الملاجئ الصوفية يمكن تقسيمه إلى أربع فترات، ترتبط كل منها بتطور الصوفية نفسها.
⦁ الرباط
كانت الرباط في الأصل حصونًا عسكرية وتبشيرية عربية، وقد تحولت تدريجيًا بمرور الوقت إلى مباني تجارية أو فندقية في الأساس، تسمى الخانات، أو في حالات نادرة، إلى رباط للصوفيين. وفي وقت لاحق، اعتبارًا من القرن التاسع، في آسيا الوسطى، تم بناء رباطات خاصة للصوفيين. على سبيل المثال، نعلم أنه كان هناك واحد في نصاف بفضل المعز بن يعقوب، وأيضاً اثنان في سمرقند – المربع، تم بناؤهما في عهد إسماعيل السماني (القرن التاسع) والأمير (القرن الحادي عشر)، بالقرب من مدرسة تمجاش خان8. المصادر المكتوبة فقط هي التي تسمح لنا بالقول إن الرباطات في آسيا الوسطى، خاصة بين القرنين التاسع والثاني عشر، لعبت دور نزل للصوفيين. يمكننا أن نفترض أن مخطط كل هذه المباني تم تنظيمه حول فناء لأنه مرتبط عضويا إلى الرباط العسكري والخانات التي كان لها نفس الهيكل.
⦁ الخانقاه
في الأصل، كانت هذه أماكن لمرور الصوفيين. هذا هو المكان الذي تجري فيه الطقوس الدينية المجتمعية والمناقشات وأحيانًا التدريس. منذ نهاية القرن العاشر، تحولت الخانقاه، مع احتفاظها بوظائفها القديمة، إلى مراكز صوفية مع مركز للدراسة تم تشكيله حول المعلم (بير) وتلميذه (موريد).
في الفترة الأولى، تعايشت عدة أنواع من الخانقاه، مما يجعل من الصعب تطوير تصنيف دقيق. نجدهم مذكورين لأول مرة باسم الخانقاه المانوية (في سمرقند) والكرامية، في مطلع القرنين التاسع والعاشر في مافارانهر وخراسان. من المحتمل أن جميع هذه الخانقاه كانت تشبه المباني الرهبانية، حيث تم تنظيم المباني حول فناء داخلي. غالبًا ما يتم إنشاؤها بالقرب من قبر الصوفي الموجود مسبقًا، وعلى العكس من ذلك، في منزل الشيخ المؤسس الذي دُفن بالقرب منه عندما توفي. وهذا هو حال الخانقاه وضريح أبي سعيد في مخانة (القرن الحادي عشر)، الواقعين مقابل بعضهما البعض، وخانقاه حكيم محمد الزيموني (توفي ١٠٢٥)، الواقعان مقابل شارع سوف في بخارى. من المفترض أن خانقاه زيموني هي المنزل السابق لهذا الشيخ وأن الضريح المقبب هو شلاخانته السابقة حيث اعتزل.
- الزاوية ،وفي الأصل، كانت الزاوية عبارة عن غرفة تقع في المسجد أو في مكان قريب، حيث يتم تدريس القرآن والقراءة. خلال الفترة الأولى، أصبحت موطنًا للصوفية، حيث كان يصلي ويعلم مريدين. تخبرنا وثائقنا أن مصطلح الزافية كان يستخدم في آسيا الوسطى بشكل رئيسي من قبل الأجانب (مثل ابن بطوطة في القرن الرابع عشر).
الشكل 5: خانقاه قاسم الشيخ، كرمينا، القرن السادس عشر.
الشكل 7: خانقاه ومسجد مجمع شار بكر بالقرب من بخارى، القرن السادس عشر
الشكل 8: خانقاه مجمع شاربكر، بالقرب من بخارى، غطاء الغرفة بأربعة أقواس متقاطعة، القرن السادس عشر.
منمنمة لخنقاه في الفترات المتاخرة
رباط المنستير بتونس
• زوايا الغرب الإسلامي
ظهرت أولى المنظمات الإخوانية حول الرباط. يعتبر رباط المنستير، الذي تأسس سنة 796 ميلادية (180 هجرية)، أقدم تجمع أخوية في شمال إفريقيا ، يفقد الرباط تدريجيا دوره العسكري، ويشار إليه بدلا من ذلك على أنه مكان للاعتزال والتعبد. وفي الوقت نفسه، يتم إعادة تفسير الجهاد بمعنى باطني: القتال الداخلي ضد الذات. ثم أُعلن عن تطور بظهور مؤسسة الزاوية كبديل للرباط.
منذ القرن الثاني عشر، بدأت العديد من الزوايا في ترسيخ نفسها في النسيج الحضري المغاربي وانتشرت مع تزايد تأثير الأخويات الدينية في هذه المنطقة .. ومن خلال وضع نفسها في أعلى التسلسل الهرمي، فإن أماكن التعبير عن العقيدة الصوفية ستمثل نفسها كأقطاب للهوية الإقليمية. وبعد ذلك، تطورت على مساحات شاسعة، وجمعت معًا مجموعات سكانية لها نفس الحساسية.
ففي الغرب الإسلامي نستخدم أيضًا في كثير من الأحيان مصطلح "سيدي" أو "لالة" و"سيدة" التي تنسب إلى النساء لتعيين شخصية مقدسة. والأخيرة تبث "بركة " مما قد يكون حافزا لتعلق الحجاج بالحج
الممارسات من أجل التغلب على التوترات الاجتماعية ومظاهرها وانعكاساتها المختلفة . لقد دُعي القديسون إلى تقديم العديد من الشكرات والفوائد وبالتالي لعب أدوار اجتماعية ودينية. تم الحصول على قوى التوماتورجيكا والحماية والشفاء والرعاية من الأفراد الذين يمثلون قنوات الكرامات (المعجزات). يوضح مثال مقام "سيدي الميزري" كيف عملت أيديولوجية البركة والتبجيل الجماعي للأولياء في بيئة محددة وشكلت تكوينها الاجتماعي والثقافي والأخلاقي.
تركز الزاوية وتثبت تمثيلات المرابطية، وبالتالي تشكل الإطار المميز لممارسات الطاعة الروحية الصوفية. يتم تعريفها أولاً على أنها الممارسة الأساسية لطقوس الأخوات الصوفية التي لها جانب عقائدي وجانب خارجي. الميتافيزيقا الصوفية هي في قلب النظام. وهذه الطقوس التي محل التعبير عنها الفضاء المرابطي، متعددة الأوجه.
تشير الطقوس إلى الطريقة التي يحدد بها الأفراد انتماءاتهم الثقافية من خلال نظام فريد من التمثيلات المكانية والزمانية، وتشير الممارسات بشكل أو بآخر إلى ما يحدد السلوك الاجتماعي.
⦁ عمارة الزاوية: التركيب المعماري والتوزيع المكاني
إن شكل الكمامة الذي يتكون من قبة ترتكز على حجم مكعب هو مفهوم تقليدي قديم تم دمجه في العالم الإسلامي. وقد استعادها وتكيفها الباطنية الإسلامية، وهي تجسد في أشكالها الجمع بين المربع والدائرة. وهكذا تمثل الزاوية، في العديد من التعبيرات الممكنة، بنية نموذجية تتكون من فناء وقبة على قاعدة مربعة. وتوضح زاوية "سيدي المزري" بالمنستير هذا التصنيف جيدًا .
تتكون أي زاوية عمومًا من رواق مدخل يسمى سكيفا يطل على الفناء، وغرفة صلاة بالمسجد، وغرفة مقببة تغطي الغرفة الرئيسية المربعة الشكل وتتميز بوجود قبر ولي - يحمل اسمه - ذريح، غرفة أو أكثر لقراءة وتلاوة القرآن الكريم. وفي بعض الأحيان نجد مساحة مفضلة لحالة العزلة وهي الخلوة .
⦁ رواق المدخل: السقيفة
يقدم مكتب الاستقبال الذي يذكرنا بالسقيفة مساحة انتقالية توضح المدخل والفناء. وهذا الرواق الذي يمر من تحته الصوفي يرمز إلى الطريق، أي الفضاء الذي يمر من خلاله الصوفي لينتقل من العالم الزمني إلى العالم الروحي من خلال تذكر واستحضار النظام الإلهي. ومن خلال الممارسات الروحية التي توجهه نحو المركز (العقل)، يتجه الصوفي إلى الداخل ويبدأ بالخروج من العالم المادي الذي هو منغمس فيه. تموت النفس، وعندما تموت تترك الجسد روحيًا وتذهب بحثًا عن الروح. فهو يصف الطريق إلى التنوير الذي يؤدي، بحسب ابن عربي، إلى معرفة اليقين . ولذلك يجد الإنسان نفسه في الجانب الخفي. وها هو في علاقة داخلية مع النقطة المركزية، من الجسد ومن خلال الروح.
⦁ فناء صحن
يؤدي المدخل إلى الفناء المحمي بأحد أروقته. وهذا الفناء مربع الشكل ومفتوح على السماء. ومن حوله يتم ترتيب الغرف والغرف المغطاة. الفتحة نحو السماء ترمز إلى العلاقة بين السماء والأرض والتي من خلالها يمر أ
منطقة كونية إلى أخرى وتشارك في تقديس الفضاء الذي يجسد محور العالم على جميع مستويات البناء. باسمه صحن، فهو يرمز إلى وعاء رحمة السماء التي تتجسد في المطر والماء وبالتالي الحياة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن شكل صحن السماء يذكر في الطرح شكل الكعبة. كما تتجسد هناك أيضًا أفكار المركز والمحيط، والوحدة والتعددية، والتوجه الجاذب المركزي، والاتجاهات المتقاربة. في هذه الحالة، الفناء هو شكل معارض. إنها تشكل حضوراً حضرياً، وذلك بفضل أبعادها التي تفضل ما يسميه الصوفيون التجالي حيث يكون تجلي الله محسوساً بالحواس. ولذلك فهو مكان ظاهري .
⦁ قاعة الصلاة بالمسجد وقاعة خلوة
الباب يدل على البدء والطريق. المحراب هو الهدف والغاية والمكان الذي يجب الوصول إليه. هذا هو مكان الحقيقة. ومن وجد الباب فدخل إليه وجد الطريق الصحيح. ولهذا السبب تم تزيين هذين العنصرين فقط من المبنى بأكمله. وبالتالي، فإن اختيار أبعادها وأشكالها وألوانها يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمفهوم الروحي. بالإضافة إلى ذلك، فإن الغرفة التي تعتبر بمثابة خلوة للصوفي هي مكان مقدس حيث يذكر اسم الله بصمت أو بصوت عالٍ.
خلاصة القول، يمكن أن تكون الزاوية، من خلال رمزيتها القوية، صورة روح الصوفي الذي، من خلال سعيه على الطريق، أو الطريقة، يتجاوز العالم المادي للوصول إلى الحقيقة الإلهية، الوحدة. بهدف بيان علاقتها بالفكر الصوفي،الزاوية سوف تقدم نفسهاكموضوع مركزي للقراءة الرمزية. ومن ثم فإن البعد الروحي يقع في قلب هذه الرمزية الناتجة عن التعايش الحقيقي بين المثالي والمكاني. إن فكرة الروحانية هذه، بمحتواها الديني والثقافي والفني، تقع في قلب فهم الفضاء المعماري المرابطي. مما يعني أن هذا المكان الحافل بالتجارب والمعتقدات وآثار الخيال والأبعاد الثقافية الممثلة للفرد والمجتمع يعكس تماثلا بين المفهوم الصوفي والعمارة المرابطية.
التكية : هي ما يشبه الخلوة في بلاد الغرب الإسلامي لكنها اخذت معنى هندسي اكثر دقة وتعقيدا بالشرق خاصة في العهد العثماني وهي كلنة فارسية الأصل وتتكون من قاعة داخلية واسعة تسمى الصحن. السمعخانة وهي قاعة تستخدم للذكر، والصلاة والرقص وغرف للمريدين وهي الغرف الذي ينام بها الدراويش.
غرفة استقبال لاستقبال العامة.قسم الحريم وهو مخصص لعائلات الدراويش.قاعة طعام جماعية ومطبخ.مكتبة.دورة مياه ومستحم.
• الضريح و المزار:
لضريح لغة هو الشق الذي يكون وسط القبر، وقيل هو القبر كلّه. أما اصطلاحًا فيطلق على البناء المشيد على القبر (أي فوقه). ويتميز ببساطة الشكل والتصميم عادة، فهو بين المسجد و الدور المدنية .
وتعلو الضريح في الغالب القبة التي تكبر أحيانــًا وتتسع فتشمـل الضريح، ويسمى بقبة فلان. وتمثّل بدورهـا رمـزًا ذا قداسة، وقد تكون مفتوحـة أو مغلقـة. كما تختلف أحجام وأشكال وتركيبة الضريح والقبّة على السواء، فتكون كبيرة أو صغيرة، مربّعة أو أسطوانية، رخامية أو حجرية.
ولا يقتصر الضريح على قبر واحد في مكان واحد إذ يمكن أن نجد عدة أضرحة لشخص واحد في أماكن متفرقة. ويمثل الضريح في العرف الشعبي رمز التقوى والصّلاح، وهو مكان لالتماس البركة والخير والدعاء المستجاب. وتنقسم الأضرحة إلى أنواع: منها ما يضم رفات صاحبه؛ ومنها أضرحة الرؤيا، وهي تلك التي تم تشييدها بعد رؤية أحد الأولياء الصالحين في المنام في موقع معين؛ والأضرحة "الوهمية" وهي التي لا تحتوي على رفات، وتمّ إنشاؤها تبعا لرغبات سياسية أو دينية.
وقد مثّلت الأضرحة ملجأ للغرباء وعابري السبيل، وحتى الفارين من العدالة أحيانــًا لأنها لطالما تمتعت بالحرمة والهيبة بحيث يصعب فيها اللجوء لاستعمال القوة والعنف في تنفيذ حكم ما، أو إجبار شخص غريب على المغادرة وخلاف ذلك. وارتبط الأمر بطهارة وقداسة المكان في نظر الزوار وإيمانهم بقدرة الولي صاحب الضريح على القصاص والانتقام من أي ظالم، ونذكر من ذلك مثلا هروب المزوار الحاج سعدي سنة 1829 وطلبه النجاة من غضب الداي حسين، واختبائه بضريح الثعالبي.
و اعتمد الجزائريون على الأضرحة لحل مختلف مشاكلهم واهدافهم التي يمكن تقسيمها إلى :
• صحية
تتمثل عـادة في الشفاء من الأمراض المختلفة، وتحصيل الصحة والسلامة الجسدية، وقهر الكسل والخمول. وقد يختص ضريح ما بهذا النمط .
• نفسيــة
الحصول على الراحة والهدوء الداخلي، واتقاء الشرور، وإبعاد العين والحسد، ونيل الخير والبركة، واستجابة الدعاء. وتشترك فيها تقريبــًا كل الفئات، وترتبط إجمالاً بأغلب أماكن الزيارة.
• اجتماعيــة طلب العون والقوة، طلب الحماية والأمان، تأمين حاجة الغرباء وعابري السبيل، وإبداء التكافل الاجتماعي.
• دينيــة
تتمثل في تحقيق الاستقرار الروحي والسعادة في الدارين الدنيا والآخرة، والتقرب إلى الله عن طريق وليّه الصالح.
وتخلل هذه الزيارة طقوس الاستشفاء بالشرب والاغتسال من بئر أو عين "مباركة" قد تكون تابعة للضريح، ومضغ ثمار وأوراق الأشجـار المحيطة به وشرب منقوعها مثلاأو الحصول على الخلطات والتمائم والتعازيم والأحجبة طقوس تمارس بصفة فردية كإشعال الشموع، ونشر البخـور أوإطلاق الزغاريدأو ذات طابع جماعي كإقامة حلقات الذكر والدعاء، وترديد الأوراد والمدائح والأناشيد.
وقد تكون لاهداف حربية عبر الحصول على بركة الأولياء الصالحين كما في العهد العثماني حيث صادف قيام دولة الدانمارك بهجوم بحري ضد مدينة الجزائر سنة 1771 احتفال الجزائريين بيوم المولد النبوي الشريف، ولذلك أوقدوا الشموع حتى أضاءت المدينة بأكملها، واعتقد المهاجمون أنه استعداد للمواجهة، فقصفوا المدينة إلى أن نفذت ذخيرتهم وعادوا خائبين. وقد اعتقد السكان آنذاك أن بركة الأولياء الصالحين هي التي حمت مدينتهم وقاطنيها، وتغنوا بذلك في أشعارهم.

مدخل إلى تاريخ الحضارة الإسلامية
السداسي: الثاني
اسم الوحدة: الاستكشافية
اسم المادة: مدخل إلى تاريخ الحضارة الإسلامية
الرصيد: 01
المعامل: 01
أهداف التعليم: (ذكر ما يفـترض أن يكتسبه الطالب من مؤهلات بعد نجاحه في هذه المادة، في ثلاثة أسطر على الأكثر).
تعريف الطالب بتاريخ الحضارة الإسلامية عامة، بدور المسلمين في النهضة بالعلوم والمعارف بمآثر الحضارة الإسلامية العلمية والعمرانية
المعارف المسبقة المطلوبة: (وصف تفصيلي للمعارف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، سطران على الأكثر).
معارف عامة حول أشهر الاختراعات الإسلامية في مجال العلم
معارف عامة حول التأثير الإسلامي في نهضة أوروبا
القدرات المكتسبة:
· تمكين الطالب من فهم ماهية الحضارة الإسلامية.
· التمكن من إدراك دور الحضارة الإسلامية في التطور الحديث.
· تثمين دور الأمة الإسلامية في بناء الحضارة الإنسانية.
محتوى المادة: (إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع الإشارة إلى العمل الشخصي للطالب).
1) تعريف الحضارة الإسلامية.
2) جغرافية الحضارة الإسلامية.
3) مصادر تاريخ الحضارة الإسلامية.
4) الحواضر الإسلامية الكبرى في المشرق والمغرب والأندلس.
5) علوم الطب والصيدلة في الحضارة الإسلامية.
6) علم الفلك والأسطرلاب.
7) علم الكيمياء.
8) علم الرياضيات والبصريات.
9) العمارة الإسلامية.
10) القوانين والأنظمة الاجتماعية.
11) الأسواق في الحضارة الإسلامية.
12) الفنون الإسلامية.
13) الحرف والصناعات.
14) أثر الحضارة الإسلامية على أوروبا.
15) تراجم لأشهر العلماء المسلمين في العلوم العقلية.
طريقة التقييم: (مراقبة مستمرة، امتحان...إلخ).
علامة الامتحان60% + الأعمال الموجهة 40%
المراجع: (كتب، ومطبوعات، مواقع إنترنت، إلخ).
1) زيغريد هونكه، شمس العرب تسطع على الغرب.
2) سعد زغلول عبد الحميد، العمارة والفنون في دولة الإسلام.
3) مانويل مورينو، الفن الإسلامي في أوروبا.
4) موسى عبد اللاوي، الحضارة الإسلامية وآثارها على المدنية الغربية

مدخل إلى تاريخ الحضارة الإسلامية
السداسي: الثاني
اسم الوحدة: الاستكشافية
اسم المادة: مدخل إلى تاريخ الحضارة الإسلامية
الرصيد: 01
المعامل: 01
أهداف التعليم: (ذكر ما يفـترض أن يكتسبه الطالب من مؤهلات بعد نجاحه في هذه المادة، في ثلاثة أسطر على الأكثر).
تعريف الطالب بتاريخ الحضارة الإسلامية عامة، بدور المسلمين في النهضة بالعلوم والمعارف بمآثر الحضارة الإسلامية العلمية والعمرانية
المعارف المسبقة المطلوبة: (وصف تفصيلي للمعارف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، سطران على الأكثر).
معارف عامة حول أشهر الاختراعات الإسلامية في مجال العلم
معارف عامة حول التأثير الإسلامي في نهضة أوروبا
القدرات المكتسبة:
· تمكين الطالب من فهم ماهية الحضارة الإسلامية.
· التمكن من إدراك دور الحضارة الإسلامية في التطور الحديث.
· تثمين دور الأمة الإسلامية في بناء الحضارة الإنسانية.
محتوى المادة: (إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع الإشارة إلى العمل الشخصي للطالب).
1) تعريف الحضارة الإسلامية.
2) جغرافية الحضارة الإسلامية.
3) مصادر تاريخ الحضارة الإسلامية.
4) الحواضر الإسلامية الكبرى في المشرق والمغرب والأندلس.
5) علوم الطب والصيدلة في الحضارة الإسلامية.
6) علم الفلك والأسطرلاب.
7) علم الكيمياء.
8) علم الرياضيات والبصريات.
9) العمارة الإسلامية.
10) القوانين والأنظمة الاجتماعية.
11) الأسواق في الحضارة الإسلامية.
12) الفنون الإسلامية.
13) الحرف والصناعات.
14) أثر الحضارة الإسلامية على أوروبا.
15) تراجم لأشهر العلماء المسلمين في العلوم العقلية.
طريقة التقييم: (مراقبة مستمرة، امتحان...إلخ).
علامة الامتحان60% + الأعمال الموجهة 40%
المراجع: (كتب، ومطبوعات، مواقع إنترنت، إلخ).
1) زيغريد هونكه، شمس العرب تسطع على الغرب.
2) سعد زغلول عبد الحميد، العمارة والفنون في دولة الإسلام.
3) مانويل مورينو، الفن الإسلامي في أوروبا.
4) موسى عبد اللاوي، الحضارة الإسلامية وآثارها على المدنية الغربية

مشرق اسلامي من القرن 8 م الى القرن16م
كلية العلوم الانسانية و الاجتماعية
قسم العلوم الانسانية (شعبة تاريخ )
المستوى : السنة الثالثة (تاريخ عام )
المقياس : مشرق اسلامي 1 من القرن/8- 16م( السداسي السادس)
الأستاذ : جليل بن عتو
نظام الحكم والإدارة:
1- الخليفة:
نظام الحكم في الدولة العباسية يستمد شرعيته من الإسلام، ويتمثل ذلك بشخص الخليفة الذي هو، وفق المعتقدات الدينية الإسلامية، خليفة النبي محمد مباشرة، ويحكم من خلال الشريعة التي أرساها.
وينصّ النظام الإسلامي على أن يُختار الخليفة من قبل وجهاء الدولة والمجتمع، بطريقة تشبه الانتخاب، وذلك مدى الحياة إذا التزم بالحق والعدل، ولم يخن الأمانة الموكلة إليه كخليفة للمسلمين، غير أن هذه الطريقة لم تطبق أبدًا منذ العهد الأموي؛ حيث أخذ الخلفاء بتعيين ولي للعهد، وتحول النظام من شوري إنتخابي كما كان في العهد الراشدي إلى ملكي وراثي إبتداء من العهد الأموي.
وهناك من يشير إلى كون الخلافة منصبا دينيًّ لا دنيوي، أو جامع بينهما، أي أن الخليفة هو رأس الهرم والإمام الأول دينيًّا، وقد جمع الخلفاء العباسيون بين الزعامة الدينية والسياسية خاصة خلال عهد القوة والإزهار، ثم أصبحوا في عهود الإنحطاط لا يشكلون سوى رمزا للدولة فقط، ورغم أن أغلب الخلفاء العباسيين لم يتمتعوا بالسلطة إلا أن عددا منهم حاول القبض على زمامها، وكتب بعضهم طوعا أو كرها تنازلا للسلطان عن صلاحيات الخليفة.
2- السلاطين والولاة:
كان أول لقب حازه الرجل الثاني في الدولة العباسية هو لقب "وزير"، وكانت مهمته مساعدة الخليفة في إدارة شؤون البلاد والإشراف على تنفيذ قرارت الخليفة، وكان ذلك واضحا خلال عهد القوة والإزدهار. وبعد ذلك نظرا لتولي قادة الجيش الأتراك الوزارة مال ولاء الجيش من شخص الخليفة إلى شخص قائدهم الوزير الذي أصبح لقبه السلطان.
وأصبح السلطان يحصر مهام السلطنة في ذريته فقط وإحتكر السلطة فعليا وقاموا بسلب صلاحيات الخليفة، حيث يسيرون شؤون البلاد وفق أهوائهم ومصالحهم، قضى الكثير من الخلفاء إما قتلا أو إغتيالا على أيدي سلاطينهم.
ولم يكن منصب السلطان واحدًا فقط خلال عهود الضعف والإنحطاط، بل إن ولاة الولايات قد تحولوا إلى سلاطين على ولاياتهم يحكمون فيها ويورثون حكمها لذريتهم، ولم يعد الخليفة بغداد سوى الدعاء له في خطبة صلاة الجمعة وسك إسمه على النقد، وهكذا لم يكن هناك سلطان واحد بل مجموعة سلاطين مستقلين بشؤونهم الداخلية والخارجية تحت سيادة الخليفة الاسمية. وتحارب هؤلاء السلاطين بدولهم مع بعضها البعض في عدة محاولات للبقاء والزعامة والتوسع.
* الجيش في العهد العباسي:
الجيش العباسي كان جيشًا دائمًا مستقرًا، يقيم أغلب جنده في بغداد إلى جانب الخليفة، مع وجود جيوش منفصلة في الولايات، والتي أصبحت بعد ذلك دولا منفصلة عن الدولة العباسية. كان الجيش في عهد القوة والإزدهار يأتمر بأمر الخليفة، ثم أصبح في عهد الضعف والإنحطاط يتحرك بأمر الولاة والسلاطين.
ولم يكن هناك عسكرية إجبارية في الدولة العباسية، بل كان كل ذكر قادر على حمل السلاح يجب عليه الانضمام إلى الجيش عند إعلان الجهاد، وقد كان الجيش العباسي جيشا عقائديا يقوم على المفاهيم والشرائع الإسلامية والتي أبرزها نشر الإسلام وحماية الخلافة.
كان ينفق على الجيش من خزينة الدولة مباشرة، لذلك أثر الجيش على الوضع المالي والإستقرار السياسي، وأصبح في عهد الضعف يشكل الجيش الدور البارز في إدارة الحكم وشكل قادته جزءًا هاما من الطبقة الحاكمة. وكانت مهام جيوش الولايات أكبر من جيش الخلافة في بغداد، حيث أوكلت إليها أمور الجهاد والدفاع عن حدود الدولة، في حين ظل جيش بغداد منهمكا و منشغلا في الحروب الداخلية وتعيين الخلفاء والسلاطين وعزلهم. وكان في بغداد فصيل مستقل يدعى »حرس الخلافة»، ويلقب قائده بـ«مؤتمن الخلافة» يتبع قصر الخلافة مباشرة.
أما أسلحة الجيش فقد كانت بالنسبة للجندي تقليدية، ممثلة بالسيوف والدروع والهِراوات والمنجنيق والمدقة والدبابة القديمة، وغيرها.
وتجدر الإشارة إلى أن فكرة الإنكشارية ظهرت في كنف الدولة العباسية ومنذ عهد خلافة المأمون، وتجلت بشكل واضح في الدولة الأيوبية، حيث تقوم هذه الفكرة على شراء عبيد صغار في السن، أو أسرهم خلال الحروب، ووضعهم في معسكرات ويتلقوا تربية عسكرية وتدريب على حمل السلاح وتلقينهم العقيدة الإسلامية ومبدأ حماية الخليفة أو السلطان، وقد دعي هؤلاء فيها بعد بالمماليك عوّل عليهم السلاطين في الحروب خاصة ضد الصليبيين والماغول.
* الحياة الدينية في العصر العباسي:
يعتبر الدين الإسلامي المقوم الأساس الذي قامت عليه الدولة العباسية، وقد شهد في كنفها تطورًا كبيرًا، مؤثرا على الحياة العامة إيجابيا وسلبيا، وكان لإنتشار الإسلام بين الشعوب غير المسلمة وفهمها له بطريقتها الخاصة متأثرة بأفكارها ومعتقداتها القديمة، وظهور العديد من الإجتهادات للفقهاء والعلماء وأهل الإفتاء وغيرهم، كل هذا أدى إلى نشوء مذاهب وطوائف وفرق داخل المؤسسة الإسلامية، بعضها إندثر والبعض الآخر لا يزال موجودا إلى يومنا هذا.
ومن الطوائف الإسلامية التي نشأت في العصر العباسي نذكر المعتزلة والمرجئة والإباضية وغيرها. كما نشأت عن المذهب الشيعي عدة طوائف نتيجة اختلافات فقهية أو حول وراثة منصب الإمام، فظهرت الطائفة الإسماعيلية والطائفة العلوية والطائفة الدرزية. كما نشأت عن المذهب السني المدارس الفقهية الأربعة وهي المالكية والشافعية والحنفية والحنبلية، وأصبحت تشكل شكلا من أشكال التنوع في تفسير العقيدة. وغالبا ما كان الخلفاء يحيطون أنفسهم بقضاة من المذاهب الأربعة.
كما عرف العصر العباسي بدايات الصوفية حيث ترعرعت فيه مدارسها وتقنياتها المختلفة، ولم تكن العلاقة بين مختلف هذه المذاهب والطوائف والفرق جيدة ، إذ قامت العديد من الفتن والإقتتالات الطائفية بينها، مما أثر في كثير من الأحيان على وحدة الدولة الإسلامية واستقرارها.
وأما فيما يخص المذهب الشيعي فإن العصر العباسي يعتبر حامسا في تكوين معالم هذه هذا المذهب كما تبدو اليوم، إذ أن الدعوة العباسية وإن قامت على تقارب مع الشيعة، إلا أنها سرعان ما انقلبت عليهم، ورغم أن العباسيين قد حفظوا الإمامة الشيعية قائمة كما كانت من قبل، إلا أن أغلب الأئمة الشيعة إما اغتيلوا أو سمموا من قبل الخلفاء وغيرهم، وعلى الرغم من أن الإمام السادس جعفر الصادق قد حرّم على الشيعة التدخل في شؤون الدولة، إلا أن العلاقة ظلت متوترة، وزادت توترا بعد إختفاء الإمام الشيعي الثاني عشر محمد المهدي في عهد الخليفة العباسي المتوكل على الله، في ظروف غامضة، ويعتقد الشيعة إلى يومنا هذا أن الإمام في حالة غيبة بسبب استشراء الظلم والفساد، وأنه سيعود قبل موعد يوم القيامة ليقيم الحكم الإسلامي العادل، وتشكل إحدى الركائز الأساسية للطائفة الشيعية ومعتقداتها.
وعرف العصر العباسي ظهور العديد من الجدالات الدينية الإسلامية الفلسفية، حيث شكلت إحدى أبرز سماته، وأهم هذه الجدالات الدينية، الجدل الذي حصل حول أزلية القرآن أو خلقه؛ إذ قالت المعتزلة والإباضية بخلق القرآن، في حين قالت الأشاعرة والسنة بأزلية القرأن، بينما أغلب المسلمين يرفضون ذلك، استنادًا إلى كون القرآن، بوصفه كلام الله وهو جزءًا لا يتجزأ عنه، وأن جعل القرآن مخلوقًا يؤثر على حال الألوهية غير القابلة للتبديل أو التغير.
وهناك قضايا أخرى أثارت جدلا واسعا بين المسلمين مثل جدل حول عرش الرحمان الوارد في القرآن إن كان حقيقيا أو رمزيا، وكذا إمكانية رؤية الله يوم القيامة، أو الجدل حول جنس الملائكة والجدل المتعلق بين الجبر والإختيار للإنسان، وغيرها من القضايا والجدالات.
ومع كون الإسلام هو دين الدولة، غير أنه لا يمكن تحديد مذهب من مذاهبه أو طوائفه دينًا رسميًّا، حيث أن ذلك كان متأثرا بمذهب الخليفة حيث نجد مثلا أن المأمون والمعتصم والواثق أعلنوا الإعتزال مذهب للدولة وقام المتوكل بتعيين الشافعية أما المستعصم كان يميل إلى الشيعة، في حين مال الخلفاء في عهد السلاجقة إلى المذهب السني.
وتميز العصر العباسي كذلك بالإهتمام بجمع الحديث النبوي الشريف وغربلته للتحقق من مدى دقته وصلته بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، وأشهر جامعي الحديث الذين برزوا خلال هذا العصر نذكر البخاري ومسلم والإمام أحمد والترميذي، مما يدل على التأثير العميق للعصر العباسي في العلوم الشرعية والفقهية. ونشأت عدة مدارس تختص بعلوم الحديث، وأشهرها مدرسة المدينة المنورة ومدرسة أهل الرأي في العراق.
كما ظهر علم قراءات القرآن في العصر العباسي منعا لإختلاف القراءات بحكم تعدد اللهجات وأختير في سبيل ذلك سبعة قراء إشتهروا بعلمهم وفضلهم، وإهتم العباسيون كثيرا برعاية المدارس الفقهية وتمويلها.
وأما فيما يخص الأديان الأخرى أي المسيحية واليهودية، فقد كانت العلاقة بينهما والدولة الإسلامية جيدة، حيث أن العديد من الخلفاء والأمراء والولاة تركوا الحرية الدينية وأمروا ببناء العديد من دور العبادة مثل دير الرصافة ودير القائم وكان للمسيحيين السريان (يعاقبة ونساطرة) دورهم في ترجمة مختلف العلوم من اليونانية والسريانية إلى العربية.
وأما اليهود فقد عوملوا مثل المسيحيين، بل إن بعضهم إرتقوا إلى مناصب مرموقة في الدولة الإسلامية، وأصبح حاخام بغداد رأسا للطائفة اليهودية في العالم، بسبب التسامح والرعاية، وبني الخليفة العباسي المعتضد لليهود مدرسة تلمودية في بغداد، وبلغ عدد اليهود في بغداد لوحدها أربعين ألف خلال عهد الخليفة المستنجد حيث إشتهروا بالتجارة والصيرفة ونشاطات إقتصادية متنوعة.
إلا أن هذا التعايش تراجع خلال عهود الإنحطاط حيث هدمت بعض الكنائس ومنع أهل الذمة من ركوب الخيل ومزاولة بعض الأنشطة التجارية، كما تعرض بعضهم للسلب والنهب من قبل البدو حيث إضطر بعضهم إلى الهجرة نحو الجبال مثل الموارنة في لبنان.
* الأوضاع الإقتصادية في العصر العباسي:
كان النظام الاقتصادي في العصر العباسي نظاما إقطاعيا، وفق النظام الإقتصادي العالمي الذي كان سائدا آنذاك، وكان قوامه الزراعة، حيث توزعت الأراضي الزراعية إلى أربع مجموعات وهي أراضي الدولة التي كانت تابعة للسلطة الحاكمة تعود أرباحها للخليفة أو السلطان أو الوالي أو كبار قادة الجيش، وأراضي الإقطاعيات الخاصة الكبيرة والتي يملكها أعيان ووجهاء المدن من الأغنياء وأراضي الأوقاف والتي شكلت مواردها ممولا أساسيًّا للمساجد والمدارس ودور الضيافة للفقراء والمساكين وعابري السبيل وغيرهم، إضافة إلى أراضي صغيرة المساحة مثل البساتين والضيعات والتي تعود ملكيتها لبعض الخواص.
كان الفلاحون يعملون كعبيد لدى ملاك الأراضي ويستقرون في قرى صغيرة ويقتاتون من غلال الأرض، وكانت الحياة القروية مزدهرة ومستقرة في غالب الأحيان، وأما في عهود الإنحطاط تراجع الأمن والإستقرار بسبب الحروب والغزو والتخريب وهو ما أدى إلى النزوح نحو المدن مما أثر على النشاط الزراعي.
وأما الصناعة كانت تعتمد على الزراعة إلى حد كبير مثل صناعة السكر المستخرج من قصب السكر والتي اشتهرت في مصر والأحواز، أو صناعة المواد الغذائية المتمثلة في مشتقات الحليب وكانت تسوق في المدن. أما الصناعات الأخرى نذكر الصناعة الحربية مثل السيوف والصناعة النسيجية من حرير وصوف وكتان، وحياكة السجاد في بلاد الفرس والشام وصناعة الزجاج وزخرفته، وصناعة الورق التي إنتقلت من الصين إلى بغداد عن طريق سمرقند على يد البرامكة في عهد الخليفة هارون الرشيد، وصناعة الفخار والنحاس وصناعة بناء السفن، وغيرها.
وإنتشرت في العديد من المدن الأسواق مثل سوق الوراقين وسوق النجارين وسوق الخضار وغيرها، ويشرف على كل سوق مجموعة من العمال، ونظم أهل الصنائع أنفسهم في طوائف صناعية قصد تنظيمها والحفاظ على حقوق العاملين فيها، وكان على رأس صناعة أو حرفة أمين عليها يسير شؤونها ويحرص على سيرورة عملها ودوامها.
ونظرا لشساعة مساحة الدولة الإسلامية في العصر العباسي وتمركزها في قلب العالم القديم جعل من أراضيها معبرا تجاريا وممرا للقوافل و البضائع بين الشرق والغرب، وأشهر الطرق التجارية نذكر طريق الحرير (طريق الشمال) الذي إشتهر بتجارة التوابل والعطور، وطريق الصحراء (طريق الجنوب) الذي إشتهر بتجارة الذهب والرقيق، وكان الطريق الأول يمتد من الصين إلى أوروبا غربا، بينما الطريق الثاني بين شبه الجزيرة العربية والسودان والحبشة وصولا إلى ممالك إفريقيا. وكانت الدولة تفرض أتاوات ورسوما على القوافل مقابل تأمينها ومرورها.
وكانت العملة الرسمية الدينار وهو مصنوع من معدني الذهب والفضة، وكان نظام الضرائب وفق الشريعة من خراج وعشور وزكارة وضرائب أخرى إستثنائية مثل الرسوم والمكوس التي كانت تجبي شهريا. وكانت الغزوات إحدى مصادر الدخل حيث إعتاد العباسيون على تسيير غزوة كل صيف نحو التخوم والثغور سميت الصوائف وكان الهدف منها كسب الغنائم وفرض الضرائب والسيطرة على الأراضي وغيرها.
* الحياة الإجتماعية في العصر العباسي:
كان المجتمع العباسي مقسمًا من ناحيتين: الأولى من الناحية الدينية حيث يوجد عامة المسلمين ومن ثم الموالي وكذلك أهل الذمة يهود ونصارى، أما الناحية الثانية حسب المكانة الإجتماعية حيث صنف المجتمع إلى طبقات بداية بطبقة الحكام والتي تشمل الخلفاء والأمراء والسلاطين والولاة والوزراء وقادة الجيش، أما الطبقة الثانية ضمت علماء الدين وأعضاء السلك القضائي والفقهي والتعليمي، ثم طبقة التجار التي إنقسمت إلى فئتين، التجار الكبار والذين إعتمدت تجارتهم على الرقيق والذهب والمجوهرات، والتجار الصغار يتمثلون في الحرفيين والصناع وأرباب المهن، إضافة إلى طبقة الجيش والجند وأخيرا طبقة الفلاحين والعبيد.
وكانت العائلة الركيزة الأساسية للمجتمع العباسي؛ يرأسها كبيرها ومن حوله زوجاته وأولاده وأحفاده، وكان الأولاد غالبًا ما يعملون في مهن آبائهم مما أدى إلى تخصص العائلات في مهنٍ وحرف معينة متوارثة.
وأما المرأة في العصر العباسي يمكن تمييز دورها في مرحلتين، الأولى كان لها فيها آثارًا عديدة في الحياة العامة حيث اشتهرت العديد من المغنيات والشاعرات والأديبات وحتى السياسيات مثل الخيزران وزبيدة زوجتا هارون الرشيد وشمس النهار زوجة الخليفة المقتدي بالله وزوجة طغرل بك التي ساعدت زوجها في تسيير مختلف الشؤون والأمور. وأما في المرحلة الثانية فقد إنكفأت المرأة من جديد نحو المنزل وإنتشرت الجواري في القصور وغيرها.
* الأحوال الثقافية في العصر العباسي:
1- الشعر: شكل الشعر في العصر العباسي ثالث حلقات الشعر العربي وأكملها، وذلك بعد الشعر الجاهلي و شعر صدر الإسلام والعهد الأموي، وقد بلغ الشعر مبلغًا عاليًا بدعم الخلفاء والأمراء وغيرهم من الطبقة الحاكمة. وتخرَّج في هذا العصر أبلغ شعراء العربية وأفصحهم. وتطور الشعر في مادته وعلومه، حيث جمع الخليل بن أحمد الفراهيدي أوزان الشعر في خمسة عشر بحرًا، ثم أضاف إليها الأخفش بحرًا فظهر بذلك علم العروض.
وأبرز ما ميز الشعر العباسي تنوّع المواضيع التي طرحها والتي شملت جميع أطياف المجتمع وتشكل هذه المواضيع مرجعًا في دراسة الأحوال الاجتماعية والسياسية والإقتصادية خلال مختلف مراحل العصر العباسي من مدح خلال مراحل القوة والإزدهار إلى قدح خلال مراحل الضعف والإنحطاط. وهكذا كان الشعر أبرز الميادين التي تعكس حياة المجتمع لكونه العماد الأساس للثقافة في العصر العباسي.
و من أبرز التيارات الشعرية نذكر تيار الغزل الماجن ومن رواده أبو نواس وبشار بن برد، ومقابل هذا التيار نجد الشعر الديني والذي تمثل في مدح النبي محمد عليه الصلاة والسلام ومدح الإسلام ورموزه وأركانه، ومن رواد هذا الشعر نذكر البوصيري صاحب قصيدة " البردة"، وإنتشر كذلك شعر الزهد والتأمل الفلسفي ومن رواده أبو العتاهية وشعر التصوف الذي نبغ فيه إبن الفارض وأبو يزيد البسطامي، ومن أبرز شعراء المدح نذكر أبو الطيب المتنبي وأما شعر الهجاء برز دعبل الخزاعي وأبو تمام والشريف الرضي و في الشعر الإجتماعي نبغ فيه إبن فارس وأبو العلاء المعري.
وقد برز في العصر العباسي شعراء غير عرب بلغات أخرى مثل جلال الدين الرومي الذي كتب بالفارسية ويونس الإمري الذي كتب بالتركية وغيرهم.
2- النثر والأدب:
كان أحد المجالات الثقافية البارزة حيث تطورت العلوم الأدبية بشكل كبير فظهر فن السجع وفن المقامات وهي عبارة عن قصص خيالية لبطل واحد ذات مغازيٍ هادفة، وكان أول من صاغها بديع الزمان الهمذاني، وقد غلب عليها التكلف الأدبي.
كما انتشر فن الروايات والقصص ذات العبر مثل كتاب كليلة ودمنة لابن المقفع والذي من خلاله قدم نقدًا لاذعًا لولاة الأمر على ألسنة الحيوان، وهو من الأدب الفارسي حيث ترجم في العصر العباسي وأصبح بعدها من الأدب العالمي، ونذكر أيضا الجاحظ صاحب كتاب البخلاء والذي سرد قصص قصيرة وفكاهية حول نوادر البخلاء، ولقي هذا المؤلف نجاحًا كبيرا في أوساط المجتمع العباسي.
ومن خصائص الأدب العباسي فصاحة اللغة وتنوع الأساليب الأدبية، حيث مع ظهور أشهر الأدباء أخد تجميل النصوص والعناية بمفرداتها وظهرت منافسة كبيرة بينهم، وإلى جانب الأدب المكتوب إنتشر الأدب المحكي مثل قصص ألف ليلة وليلة وهي قصص خيالية دونت بالعربية ومنها سندباد وعلى بابا وعلاء الدين والمصباح السحري وغيرها والتي كانت تروي في جلسات وعلى شكل شفوي وكانت نصوصها مزخرفة بعبارات وأشعار محلية.
3 – نحو اللغة:
شهد العصر العباسي تطورًا هامًّا في بنية اللغة العربية؛ حيث أن أغلب الباحثين يعيدون نشأة النحو العربي إلى أبي الأسود الدؤلي، و الذي كان أول من وضع النقاط على الحروف في الأبحدية العربية، إلا أن التطور الهامّ للغة ظهر لا حقا بعده أي في العصر العباسي حيث إشتهر النحويين مثل عيسى بن العمر الثقفي، وعمرو بن العلاء والخليل بن أحمد وسيبويه (إمام العربية) ويونس بن حبيب والكساني مؤسس مدرسة الكوفة في النحو والأصمعي والزمخشري، وغيرهم.
وخلال هذا العصر أعيد ترتيب الأبجدية بالشكل المتعارف عليه اليوم وذلك بعد أن كانت مرتبة وفق الترتيب التقليدي للغات السامية، كما ظهر التشكيل بالشكل المتعارف عليه اليوم وذلك على يد الخليل بن أحمد الفراهيدي.
قد أدى إختلاط العرب بالشعوب الأخرى وتفاعلها الحضاري إلى دخول العديد من المصطلحات غير العربية، وظهرت المعاجم والقواميس العربية، حيث كان الخليل بن أحمد أول من جمع قاموسًا سماه «العين»، إضافة إلى قواميس أخرى مثل "لسان العرب " لصاحبه إبن المنظور و"القاموس المحيط" للفيروزآبادي.
وقد أدى هذا الاختلاط وبشكل تدريجي إلى نشوء اللهجات المحلية في العربية حيث تأثرت مثلا اللهجة الشامية والعراقية بالسريانية واللهجة المصرية بالقبطية وغيرها.
* العلوم في العصر العباسي:
1_ العلوم السائدة:
لم يكن لدى العرب علوما متنوعة ولم يركزوا إهتماما تهم فيها، لذلك يعود تأسيس العلم العربي للعصر العباسي، وقد إعتمد في البداية على ترجمة أعمال الفلاسفة والعلماء اليونان مثل أرسطو وأفلاطون وأرخميدس وغيرهم. وذلك بدعم من الطبقة الحاكمة، وبعدها أصبح العلماء في العصر العباسي يضيفون ويبتكرون في مختلف العلوم النظرية والتقنية، في الوقت الذي كانت فيه الأمية والجهل متفشيان في أوروبا، ولولا جهود الخلفاء العباسيين لضاع العلم الإغريقي القديم وإندثر نهائيا.
ومن أبرز المنجزات العلمية في العصر العباسي نذكر رسم أول خارطة للعالم على يد الإدريسي صاحب كتاب" نزهة المشتاق في اختراق الأفاق" و من العلماء كذلك نذكر ابن الهيثم الذي ألف مائتي كتاب في الطب والفلسفة والرياضيات والفيزياء، وتخصص في البحث في الأشعة وإنكسارها وإنعكاسها من خلال مؤلفه "المناظر" وتعود إليه العديد من الإبتكارات مثل صقل العدسات المحدبة والمقعرة، ونذكر كذلك عبد الله البتاني الذي إشتهر بعلم الرياضيات حيث أكمل تنسيق الزوايا خصوصا الجيب وجيب التمام والظل وناقش نظريات باطليموس حول الكواكب وزاد عليها في كتابه "تعديل الكواكب"، وهناك أيضا إبن سينا الملقب بالطبيب الرئيس وصاحب المؤلف المشهور "القانون في الطب"، وفي مجال الصيدلة برز إبن البيطار والذي ساهمت رحلاته في معرفة أنواع النباتات وتركيب العقاقير الطبية وقد ألف العديد من الكتب أشهرها "الجامع في المفردات الطبية"، إلى جانب العالم الكيميائي جابر بن الحيان الذي نال دعم هارون الرشيد وأسس رفقة تلامذته منهج التجربة في العلوم وهناك أيضا الكندي وهو من أبرز الفلاسفة، إضافة إلى أبو بكر الرازي الذي نبغ في الطب وله عدة مؤلفات طبية أهمها "الحاوي "، كما إشتهر كل من إبن كثير والمقريزي في التاريخ وإنبثق عنه علم أنساب العرب وتدوين سير أعلامهم مثل كتاب "وفيات الأعيان" لإبن خلكان، ونذكر كذلك الخوارزمي عالم الجبر وهو من وضع أول لوغاريتم في العالم كما برز علماء آخرون غير مسلمين مثل ثيوفيل بن توما الذي شغل منصب كبير علماء الفلك لدى الخليفة وقيس الماروني الذي إشتهر بالتأريخ وجرجس بن بختيشيوع الذي كان طبيب وحنين بن إسحاق مترجم علوم اليونان وغيرهم كثيرون جدا.
2- الترجمة:
اهتمّ العباسيون بترجمة الكتب والمخطوطات القديمة إلى العربية، وشكل ذلك بداية الثورة الفكرية والحضارية في العصر العباسي وكان العرب يجهلون اللغة اليونانية التي دونت بها المؤلفات العلمية القديمة لأمثال أرسطو وأفلاطون و إقليدس وغيرهم. ونظرا لإهتمام الخلفاء العباسيين خاصة أبو جعفر المنصور وهارون الرشيد وابنه المأمون بالعلوم، فقد عهدوا بعملية الترجمة إلى السريان، وقد كانت الترجمة تتم على مرحلتين، الأولى من اليونانية إلى السريانية والثانية من السريانية إلى العربية، وبفضل الترجمة إستطاع العرب نقل الأدب السرياني بكامله.
وإزدهرت عملية الترجمة في الفترة ما بين عامي 750م و900م، حيث ترجمت أمّهات الكتب السريانيّة واليونانيّة والفارسيّة إلى العربيّة وكان على رأس المترجمين في بيت الحكمة "حنين بن إسحاق" الذي ترجم إلى اللغة السريانيّة مائة رسالة من رسائل جالينوس وإلى العربيّة تسعًا وثلاثين رسالة أخرى، وترجم أيضًا كتب "المقولات الطبيعيّة والأخلاق الكبرى" لأرسطو، وكتاب "الجمهورية " وكتاب "القوانين والسياسة" لأفلاطون، وكان الخليفة المأمون يعطيه ذهبًا زنة ما ينقله من الكتب. وقام ابنه اسحاق في أعمال ترجمة مؤلفات أرسطو في الميتافيزيقيا والنفس وغيرها، ونقل إليها شروح الإسكندر الأفروديسي.
وكان قسطا بن لوقا يشرف على الترجمة من اللغات اليونانيّة والسريانيّة إلى العربيّة، وأقام الخليفة المأمون الترجمان يوحنا بن البطريق أمينًا على ترجمة الكتب الفلسفيّة. وإهتم بالترجمة كل من الخلفاء والوزراء والأمراء والأغنياء وأنفقوا الأموال الطائلة في سبيلها، وهكذا شكلت الترجمة إحدى أسس بناء الحضارة العربية الإسلامية وأصبحت اللغة العربية لغة علم بعدما كانت لغة أدب وشعر، وهو الأمر الذي ساهم في سيرورة الحضارة الإنسانية.
* العمارة في العصر العباسي:
اهتم العباسيون بالعمران واعتنوا عناية واضحة به، فعمدوا على إنشاء العديد من المدن الجديدة، وأشهرها مدينة بغداد إضافة إلى مدن كبرى مثل سامراء والواقفة والمتوكلية والرحبة وغيرها. كما قام العباسيون بإنشاء شبكة واسعة من الطرق والجسور خاصة في العراق، وشيدوا المدارس والجامعات والمستشفيات والحمامات العامة في المدن الكبري، إضافة إلى التكايا التي كانت تستضيف الفقراء وعابري السبيل والفنادق ...
وتأثر فن العمارة العباسية بالعمارة العراقية القديمة خاصة الأشورية وكذلك العمارة الفارسية، ولعل تصميم بغداد بشكل دائري له أربعة أبواب هو أحد أبرز التأثر بالعمارة الأشورية. وإنتقل هذا النمط المعماري من العراق عن طريق السلاطين والولاة إلى مناطق أخرى مثل مصر وبلاد الشام. ويشكل إستعمال الآجر والطين لبناء القصور بدلا من الحجارة أبرز مظاهر التأثر بالعمارة الفارسية.
وتمازجت مع العمارة الفنون الزخرفية، حيث كانت زخرفة المساجد والقصور والقباب من أبرز مجالاتها، وبأشكال هندسية أو نباتية أصبحت تعرف بإسم أرابيسك «Arabesque» أي الزخرفة العربية. كما انتشر في العصر العباسي بشكل خاص الفن التجريدي حيث عمد العباسيون إلى عزل عنصر الزخرفة عن محيطه الطبيعي تعبيرا منه عن النقاء وإعطاء شعورًا بالدوام والبقاء وهو ما تجلى في الزخرفة النباتية.
كما عرفت زخرفة الحروف العربية تطورا كبير حيث أصبحت علمًا قائمًا أي علم الخط العربي، وتميزت الزخرفة في العصر العباسي كذلك كونها زخرفة كارهة للفراغ إذ يقوم الفنانون برسم الزخارف الكبيرة والصغيرة والمتوسطة بحيث تملأ جميع الفراغات بزخارف أكثر دقة، وإزدهر كذلك فن الفسيفساء المستنبطة من الحضارة البيزنطية.
مطبوعة دروس: العمران و المراكز الحضارية بالمغرب الإسلامي ...للدكتورة بوتشيش آمنة
برنامج مقياس العمران و مراكز الحضارية بالمغرب الإسلامي
1/ مدخل إلى العمران الإسلامي
2/ نشأة المدينة الإسلامية
3/ أنواع العمران الإسلامي
4/ العمران في الفكر الإسلامي
5/ التخطيط المدنية
6/ التحولات العمران في بلاد الغرب الإسلامي بعد الفتح الإسلامي (القيروان)
7/ الحروب و الهجرات و أثرها على العمران.
8/ خصائص المعمار الإسلامي
9/ العمران و الديمغرافية في المدينة المغربية في العصر الوسيط (أ نموذج مدنية بجاية).